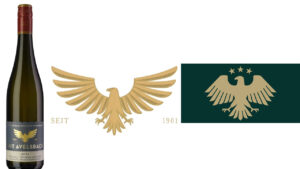د. أحمد الخليل
أوراسيا
كي نفهم العالم القديم لا بد من فهم الجغرافيا السياسية حينذاك.
وكي نفهم الجغرافيا السياسية لا بد من فهم الجغرافيا البشرية والحضارية.
فالعالم القديم، من حيث الجغرافيا البشرية والحضارية، كان مؤلفاً من ثلاث قارات، هي آسيا وأوربا وإفريقيا، وكانت آسيا وأوربا هما مركز الثقل البشري والحضاري، أما قارة إفريقيا فكان الجزء الشمالي فقط (من مصر إلى دولة المغرب) هو المعروف حضارياً وسياسياً، باعتباره يتاخم آسيا شرقاً، ويطل على البحر الأبيض المتوسط، فيتاخم أوربا شمالاً. ومن الباحثين الإستراتيجيين من يسمي آسيا وأوربا باسم (أوراسيا)، باعتبارهما قارتين متصلتين جغرافياً، ومتواصلتين حضارياً وبشرياً، ولا أرى مانعاً من استخدام هذا الاسم.
أما آسيا فكانت المراكز الحضارية فيها هي: سوريا الكبرى القديمة، وآسيا الصغرى (غربي تركيا حديثاً)، وبلاد الرافدين (جنوب ووسط العراق حديثاً) ، وآريانا (كردستان وفارس وأذربيجان حديثاً)، والهند (بما فيها باكستان حديثاً)، والصين وامتداداتها الحضارية المتاخمة لها في دول شرقي آسيا حديثاً.
وأما في أوربا فكان المركز الحضاري الأبرز هو بلاد اليونان، ثم ظهر جيرانهم الرومان في إيطاليا. وأما في الزاوية الشمالية الشرقية من إفريقيا فكانت مصر هي المركز الحضاري المتميّز، ومن يتتبّع النشاط المصري السياسي والحضاري قديماً يكتشف أن مصر كانت تدخل في علاقات سياسية واقتصادية مع دول غربي آسيا وجنوبي أوربا، أكثر بكثير من علاقاتها مع المجتمعات الإفريقية.
إذا أخذنا هذه الحقائق في الحسبان كنا أقدر على فهم حروب العالم القديم، فقيام دول وإمبراطوريات قديماً كان يعني وجود كثافة بشرية معيّنة، وكان يعني من ثم وجود موارد اقتصادية، ووجود أسواق تجارية، وكانت الحرب تنشب لأن دولة ما أو إمبراطورية ما كانت تريد السيطرة على تلك الموارد، والوصول إلى تلك الأسواق، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتوافر طرق تجارية سالكة آمنة، ولا تكون تلك الطرق سالكة وآمنة إلا إذا كانت تمر في أرض صديقة، أو تمر في أرض تقع تحت السيطرة، وأرى من جانبي أن تحليل دوافع الحروب القديمة بعيداً عن هذه الحقائق هو جهد ضائع، وسير في الاتجاه الخاطئ.
مصالح.. وحروب
وكان في العالم الأوراسي القديم (نسبة إلى أوراسيا) طريقان تجاريان عالميان:
– الأول هو طريق الحرير: وكان يبدأ من الصين شرقاً، ويمر بوسط آسيا، ثم بآريانا، فبلاد الرافدين، ويصل إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط عبر آسيا الصغرى وسوريا، وكان هذا الطريق هو الأهم، لأنه يوصل إلى جغرافيا بشرية وحضارية أكبر، وأكثر فعالية.
– والثاني هو طريق البخور: وكان يبدأ من موانئ اليمن، في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية، ويمر بمنطقة الحجاز في غربي شبه الجزيرة العربية، وكان فرع منه يتجه شرقاً إلى بلاد الرافدين فآريانا، ويتوجه فرع آخر شمالاً، فيدخل جنوبي سوريا الكبرى، ويصل من هناك إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وإلى مصر، فيربط بين المراكز الحضارية في جنوبي أوربا، والمراكز الحضارية في الهند وجنوب شرقي آسيا.
ولو تتبعنا مسارات الحروب القديمة لوجدنا أمراً مثيراً حقاً، فالطرق والاتجاهات والميادين التي كان يسلكها الجنود ويرتادونها هي نفسها التي كان التجار يسلكونها ويرتادونها، ولاكتشفنا أيضاً أن المنطقة الواقعة بين السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وآريانا كانت المنطقة الأكثر سخونة على الصعيد الحربي في العالم القديم.
فكي تتواصل دول بلاد الرافدين (الأكاديون، البابليون، الآشوريون) مع جنوبي أوربا غرباً كان لا بد من السيطرة على سوريا وآسيا الصغرى، وكي تتواصل مع وسط آسيا شرقاً، وتجعل الطريق سالكة إلى الصين، كان لا بد من السيطرة على آريانا (كردستان وفارس وأذربيجان)، وقل الأمر نفسه في التوسع الميتاني (الحُوري) شرقاً وغرباً، وفي التوسع المصري شرقاً وشمالاً، وفي التوسع الميدي والأخميني والساساني غرباً وشرقاً، وفي التوسع اليوناني بقيادة الإسكندر شرقاً، ثم في التوسع الروماني والبيزنطي شرقاً، وكذلك في التوسع العربي الإسلامي غرباً وشرقاً.
وعلى ضوء هذه الحقائق الجغرافية، بمضامينها البشرية والحضارية، نفهم إصرار الترك السلاجقة على الامتداد من أفغانستان شرقاً، نحو آريانا وبلاد الرافدين (العراق)، ثم نحو سوريا الكبرى وآسيا الصغرى، والوصول إلى سواحل البحر المتوسط الشرقية، وعلى ضوء هذه الحقائق أيضاً نفهم امتداد الدولة الأيوبية الكردية من مصر غرباً إلى سوريا الكبرى فكردستان شمالاً وشرقاً، ونفهم حرص الدولة الخوارزمية على السير في الاتجاه نفسه الذي سار فيه السلاجقة، ونفهم أيضاً انطلاقة المغول من شرقي آسيا نحو البحر الأبيض المتوسط، وانطلاقة الحملات الفرنجية (الصليبية) من أوربا نحو آسيا الصغرى وكردستان وسوريا الكبرى ومصر، بل لك أن تفسر على ضوء هذه الحقائق أيضاً التوسع الاستعماري الأوربي، في العصر الحديث، من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى قلب القارة الهندية.
أخطار غرباً.. وأخطار شرقاً
في النصف الثاني من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) كانت الدولة الأيوبية تمتد من حدود أذربيجان شرقا وشمالاً إلى ليبيا غرباً وجنوباً، وتضم بعض أرمينيا، وكردستان، وبلاد الشام، والحجاز، واليمن، ومصر، وشمالي السودان، وأجزاء من ليبيا، لكن الصراعات على السلطة كانت قد نشبت بين أبناء الأسرة الأيوبية، فحدّت من قوتها ونالت من هيبتها، وظهرت هذه الخلافات في وقت عصيب جداً، إذ كانت القوى الإقليمية المحيطة بالأيوبيين بين عدو ومنافس.
فمن الغرب كان الفرنج الشرقيون (فرنج بلاد الشام)، ومن ورائهم بابا الفاتيكان وملوك أوربا، ينتهزون كل فرصة ممكنة للانقضاض على الدولة الأيوبية، والإجهاز عليها، واسترداد الممتلكات التي خسروها في حروبهم ضد السلطان صلاح الدين، وكان الغرض من الحملتين الصليبيتين الرابعة والخامسة هو تحقيق ذلك الهدف.
ومن الشمال كانت الدولة البيزنطية ما تزال قوية، ويمكنها أن تتعاون مع التحركات الفرنجية، وتشكل تهديداً للدولة في أي وقت، كما كان سلاجقة الروم، في آسيا الصغرى، منافسين خطيرين للأيوبيين، وكان يهمهم أن يبسطوا نفوذهم على مناطق كردستان (شرقي تركيا حالياً)، كما كان الجورجيون يقودون حملات صليبية من نوع آخر على الممتلكات الأوربية في أرمينيا وكردستان كلما سنحت لهم الفرصة.
على أن ثمة خطرين كبيرين آخرين كانا قادمين من الشرق:
- الأول هو الخطر الخوارزمي: فقد كانت الدولة الخوارزمية، وهي دولة تركية، تابعة للسلاجقة في البدء، وفي سنة (596 هـ) تولّى محمد علاء الدين خوارزم شاه السلطة، وحكم مستقلاً عن السلاجقة، ووسّع رقعة الدولة من تركمانستان الحالية شرقاً إلى تخوم كردستان والعراق غرباً، ويذكر المؤرخون أن خوارزم شاه أراد الهيمنة على مقاليد الأمور في بغداد عاصمة الخلافة، كما فعل السلاجقة سنة (447 هـ/1055 م)، لكن الخليفة الناصر لدين الله (ت 622 هـ) أعرض عن مطالب خوارزم شاه، فصمّم خوارزم شاه على غزو بغداد سنة (614 هـ)، وأصبحت منطقة نفوذه تتاخم الدولة الأيوبية شرقاً، مهدداً إياها على نحو مباشر. (انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 12/316، وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، 9 /230، 232).
والحقيقة أن خوارزم شاه كان سيتجه إلى غربي آسيا للسيطرة عليها؛ ليس بدافع الانتقام من الخليفة العباسي، وإنما كانت الجغرافيا السياسية- وهي جغرافيا بشرية واقتصادية ضمناً- ستضطره إلى ذلك.
- والثاني هو الخطر المغولي: ويذكر المؤرخون أن تهديد خوارزم شاه للخلافة العباسية في العراق حملت الخليفة الناصر لدين الله على الاستعانة بالمغول، فهم كانوا جيران خوارزم شاه شرقاً، يقول المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 254 – 255): ” وفي خلافته [الناصر] خرب التتر بلاد المشرق، حتى وصلوا إلى هَمَذان، وكان هو السبب في ذلك، فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد، خوفاً من السلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه، لما همّ بالاستيلاء على بغداد، وأن يجعلها دار ملكه كما كانت السلجوقية “.
ويذكر المؤرخون أيضاً أن هرب جلال الدين، آخر سلطان خوارزمي، من وجه المغول، وتوجهه غرباً نحو فارس وكردستان وأذربيجان، هو الذي جعل المغول يتوجهون إلى غربي آسيا. والذي نراه أن المغول كانوا سيفعلون ذلك في كل الأحوال، سواء أهرب منهم جلال الدين أم لم يهرب، فالجغرافيا السياسية -وهي جغرافيا بشرية اقتصادية ضمناً- كانت ستضطرهم إلى ذلك.
في هذه الظروف السياسية الحرجة كانت الدولة الأيوبية تشكّل القوة الإقليمية الأكثر نفوذاً في غربي آسيا، وكان يقودها حينذاك السلطان الكامل ابن السلطان العادل الأيوبي، ماذا عن الكامل وإنجازاته؟
نشأة الكامل
هو أبو المعالي محمد بن السلطان العادل ابن أيوب، ولقبه الملك الكامل ناصر الدين، وترتيبه الخامس من سلاطين بني أيوب، وليس السادس كما ذكر المقريزي (السلوك، ج1، ق1، 230)، ومولده سنة (576 هـ) خمسمئة وست وسبعين هجرية.
وكان السلطان العادل قد قسّم البلاد في حياته بين أولاده، فجعل بمصر الكامل محمداً، وبدمشق، والقدس، وطبريّة، والأردنّ، والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها، ابنه المعظّم عيسى، وجعل بعض ديار الجزيرة، ومَيّافارقين، وخِلاط وأعمالها، لابنه الأشرف موسى، وأعطى الرُّها لولده شهاب الدين غازي، وأعطى قلعة جَعْبَر لولده الملك الحافظ أرسلان شاه، وكان يتردد بين أبنائه، ويتنقّل بين ممالكهم، ولا ريب أنه كان يفعل ذلك للاطمئنان إلى أنهم يسوسون الأمور سياسة صائبة، ولتوجيههم الوجهة الصحيحة، وكأنما كان يدرّبهم على أصول الإدارة وشؤون سياسة الرعية، قال ابن الأثير (الكامل في التاريخ، 12/352):
” فلمّا توفّي [العادل] ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه أبوه، واتفقوا اتفاقاً حسناً، لم يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين أولاد الملوك بعد آبائهم، بل كانوا كالنفس الواحدة، كل منهم يثق بالآخر، بحيث يحضر عنده منفرداً من عسكره، ولا يخافه، فلا جَرَم زاد مُلكهم، ورأوا من نفاذ الأمر والحكم ما لم يره أبوهم. ولعمري إنهم نعم الملوك، فيهم الحِلم، والجهاد، والذبّ عن الإسلام، وفي نوبة دمياط كفاية “. (وانظر ابن خلّكان: وفيات الأعيان، 5/77- 78).
ويستفاد مما جاء في ترجمة السلطان العادل أنه كان كثير الاعتماد على ابنه الأكبر الملك الكامل، حسن الرأي فيه، فحينما انصب اهتمامه على دمشق وجنوبي بلاد الشام أناب عنه ابنه الكامل في حكم كردستان، وهذا يعني أنه وقع على الكامل عبء مواجهة الزنكيين في الموصل شرقاً، ومواجهة الأراتقة في الأناضول الشرقية غرباً، ومواجهة الجورجيين على حدود أرمينيا شمالاً.
وفي سنة (596 هـ) ستمئة وست وتسعين هجرية كان الأفضل والظاهر ابنا صلاح الدين قد ضيّقا الخناق على عميهما العادل في دمشق، ” وقد خربت البساتين والدور، وقطعت الأنهار، وأحرقت الغلال، وقلّت القوات، وعزم العادل على تسليم دمشق لكثرة من فارقه “، فاستدعى ابنه الكامل من كردستان، فهبّ الكامل إلى نجدة أبيه بعسكر قوي، ووقع الوهن في عسكر الأفضل والظاهر (المقريزي: السلوك، ج1/ ق1، ص 181).
وفي سنة (596 هـ) خمسمئة وست وتسعين هجرية نفسها عزل العادل السلطان الصبي المنصور ابن السلطان العزيز عن السلطنة، وتولاّها بنفسه، فكان أول ما قام به أنه استدعى ابنه الكامل من كردستان، ” ونصبه نائباً عنه بديار مصر، وجعل الأعمال الشرقية إقطاعه، كما كانت إقطاعاً للعادل في أيام السلطان صلاح الدين، وجعله وليّ عهده، وحلف له الأمراء ” (المقريزي: السلوك، ج1/ ق1، ص 184).
على أن مواهب الكامل القيادية تجلّت على نحو أفضل بعد وفاة أبيه، حينما تولّى مقاليد السلطنة، ووجد نفسه يحل محلّ أبيه في مقارعة الحملة الصليبية الخامسة.
فماذا عن جهوده في رد تلك الحملة؟
الحملة الصليبية الخامسة
مر في ترجمة السلطان العادل أن الفرنج كانوا قد غيّروا إستراتيجيتهم، فبدل أن يهاجموا بلاد الشام، لاسترداد القدس، قرروا الاستيلاء على مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الأكثر تأثيراً، وباعتبارها مركز الدولة الأيوبية، وشرعوا في تنفيذ خطتهم هذه سنة (615 هـ/1218 م)، وكان السلطان العادل قد أناب عنه في مصر ولده الملك الكامل، وتفرّغ في بلاد الشام لمحاربة الفرنجة، وكان الفرنج قد نقضوا، في سنة (610 هـ/1212 م)، الصلح الذي كان قائماً بينهم وبين الأيوبيين، وكانوا يحشدون قواتهم في الساحل السوري، ولا سيما في عكا، بهدف استرداد القدس وسائر المناطق التي خسروها في عهد صلاح الدين.
ومر أن الحملة الصليبية الخامسة بدأت سنة (615 هـ/ 1218 م)، وكان القائد العام لها هو جان دى بريين، ملك مملكة المقدس، وانطلقت الحملة في أسطول ضخم، يحمل عشرة آلاف فارس، ومئتي ألف راجل، وكانت الوجهة مدينة دمياط، على الساحل المصري.
ومر أيضاً أن الجيش الأيوبي استبسل في الدفاع عن دمياط، وأصر الفرنج على احتلالها، وكان يتوسط الطريق إلى دمياط من جهة البحر برج ضخم مقام في وسط النيل، يدعى (برج السلسلة)، بسبب سلسلتين كانتا تمتدان منه: تتجه إحداهما إلى دمياط على الضفة الشرقية، وتتجه الأخرى إلى البر الغربي المقابل لدمياط، وكان البرج مشحوناً بالمقاتلين، وكان مفتاح الحول إلى دمياط.
لذلك ركّز الفرنج جهودهم كلها للاستيلاء على ذلك البرج، وقاموا ببناء أبراج خشبية عالية، وأقاموها على سفنهم، وتقدموا بها إلى برج السلسلة لمحاربة حاميته، ولكن المقاتلين المتحصنين في البرج ردوا الفرنج على أعقابهم أكثر من مرة، وحطّموا سفنهم الحربية وآلاتهم، ومع ذلك لم يفقد الفرنج الأمل في السيطرة على البرج، وظلوا يحاصرونها أربعة أشهر.
وخلال ذلك كان الملك الكامل قد توجه بجنوده من القاهرة إلى دمياط، ونزل بقواته في العادلية، وهي مدينة كان والده العادل أسسها سنة (614 هـ) ستمئة وأربع عشرة هجرية جنوبي دمياط، على الضفة الشرقية للنيل، وزوّدها بالمقاتلين، خوفاً من أن يقوم الفرنج بمهاجمة دمياط من جهة البحر.
وظل المدافعون عن البرج يقاومون هجمات الفرنج بشجاعة، لكن الفرنج بنوا برجاً عالياً آخر، ونصبوه على سفينة كبيرة، وأقلعوا به، إلى أن أسندوه إلى برج السلسلة، وراحوا يقاتلون الحامية الأيوبية داخل البرج، وانتهى القتال العنيف باستيلائهم على البرج عنوة.
وكان لسيطرة الفرنج على برج السلسلة نتائج عسكرية خطيرة، وكان السلطان العادل، وهو في الجبهة الشامية، أدرى الناس بتلك النتائج، ويعرف أن السيطرة على دمياط يعني أن الفرنج سينطلقون في المرحلة الثانية من حملتهم إلى القاهرة عاصمة السلطنة، وذكر المقريزي (السلوك، ج1، ق1، 225) أنه لما وصل خبر سيطرة الفرنج على البرج إلى العادل ” تأوّه تأوّهاً شديداً، ودقّ بيده على صدره أسفاً وحزناً، ومرض من ساعته “، وانتهى ذلك المرض بوفاته هماً وغماً.
تكتيكات حربية
بوفاة السلطان العادل في سوريا وقع عبء مجابهة الفرنج في مصر على السلطان الكامل، وكان عبئاً ثقيلاً، فبعد سيطرة الفرنج على برج السلسلة، وتحطيم السلسلتين المتصلتين بالبرج، أصبح الطريق مفتوحاً أمام سفنهم للعبور نحو دمياط، فأمر الكامل بإقامة جسر من السفن في النيل، لمنع سفن الفرنج من التقدم، لكن الفرنج قاتلوا قتالاً شديداً، وتمكنوا من قطع الجسر واختراقه.
وهنا لجأ الكامل إلى خطة أخرى يمنع بها الفرنج من التقدم إلى دمياط، فأمر بإغراق عدد من السفن في عرض النيل، غير أن الفرنج اهتدوا بالمقابل إلى خطة حربية، يتغلبون به على خطة الكامل، إذ عمدوا إلى خليج قديم كانت الرمال قد طمرته، فأعادوا حفره، ومرروا إليه المياه، وصعدوا فيه بسفنهم، إلى أن أصبحوا في مواجهة معسكر الكامل في العادلية.
وبعد أن أصبح الجيشان الأيوبي والفرنجي متقابلين، دارت بينهما معارك حربية طاحنة، تمكن خلالها الجيش الأيوبي من أسر سفينة فرنجية حربية كبيرة، مصفحة بالحديد، وظلت المعارك قائمة بين الفريقين أشهراً عديدة، في حين كانت مدينة دمياط تنعم بالأمن، وكانت أبواب سورها مفتوحة لتلقي الإمدادات والأقوات من الجانب الأيوبي، فقد كان نهر النيل يفصل بينها وبين الفرنج.
وقد نهج الكامل نهج السلطان صلاح الدين في حربه ضد الفرنج، إذ كان صلاح الدين يوظف كل الإمكانات المتاحة لتحقيق النصر، ومنها استثمار براعة البدو (العربان حسبما يسميهم المقريزي) في السطو، وفعل الكامل الأمر نفسه، فسلّط البدو على معسكر الفرنج، فكانوا يتسللون إلى خيامهم ليلاً، بل صاروا يدخلونها نهاراً أحياناً، ويتخطفونهم من كل جانب؛ الأمر الذي بث فيهم الذعر، ودفعهم إلى التحارس وعدم النوم ليلاً. (المقريزي: السلوك، ج1، ق1، 231).
وكانت إستراتيجية صلاح الدين تقوم أيضاً على حشد شعوب شرقي المتوسط، كرداً وعرباً وتركاً، كلها في خندق المقاومة، وهذا ما فعله الكامل أيضاً، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، 231):
” وبعث السلطان إلى الآفاق سبعين رسولاً، يستنجد أهل الإسلام على قتال الفرنج، ويستحثهم على إنقاذ المسلمين منهم وإغاثتهم، ويخوّفهم من تغلّب الفرنج على مصر، فإنه متى ملكوها لا يمتنع عليهم شيء من الممالك بعدها، فسارت الرسل في شوّال، فقدمت النجدات من حماة وحمص “.
صراع كردي- كردي
إلى هذا الحين كانت الجبهة الأيوبية متماسكة وفاعلة، ولم يستطع الفرنج التقدم نحو دمياط، لكن سرعان ما ظهرت بوادر التفكك بعد وفاة السلطان العادل، وطمع في السلطان الكامل من طمع، فمن ناحية أثار البدو الاضطرابات في أرض مصر، وقاموا بالعصيان والتمرد ” وكثر خلافهم، واشتد ضررهم “؛ كما قال المقريزي؛ الأمر الذي أضرّ بجهود الكامل الحربية في أكثر من ميدان.
ومن ناحية أخرى برزت خلافات مراكز القوى، ومعروف أن مراكز القوى في الدولة- أية دولة كانت- تتوارى حينما يكون الحاكم قوياً، وسرعان ما تطل برؤوسها وتنشط حينما يضعف الحاكم أو يتوفى، ويحل محله حاكم جديد لمّا يرسّخ سلطته بعدُ، وبطبيعة الحال تكون الجهة الخاسرة هي الراغبة في تغيير الواقع السياسي، وهي الساعية لإحلال واقع يكون لها النصيب الأوفى فيه.
والملاحظ أن معظم المؤرخين المسلمين القدماء يكتفون بسرد الحدث التاريخي، ولا يولون الاهتمام الكافي لتحليل العوامل التي أنتجت ذلك الحدث، وقد يذكرون بعض العوامل، لكنهم يغفلون العوامل الأخرى، وتجد نفسك في النهاية أنك عرفت الحدث، لكنك تجهل المناخ الذي أنتجه، وبعبارة أخرى: إن المؤرخ القديم يجيد السرد، لكنه يقصر في التحليل؛ وخير مثال بين أيدينا على ذلك هو الخبر الآتي الذي أورده المقريزي؛ فبعد أن ذكر الاضطرابات التي أثارها البدو في مصر، قال: (السلوك، ج1، ق1، 231 – 232):
” واتفق مع ذلك قيام الأمير عماد الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين أبي الحسين علي بن أحمد الهكّاري، المعروف بابن المشطوب، وكان من أجلّ الأمراء الأكابر، وله لفيف من الأكراد الهكارية، ينقادون إليه ويطيعون، مع أنه كان وافر الحرمة عند الملوك، معدوداً بينهم كواحد منهم، معروفاً بعلو الهمة، وكثرة الجود، وسعة الكرم، والشجاعة، تهابه الملوك، وله وقائع مشهورة في القيام عليهم، ولما مات أبوه، وكانت نابلس إقطاعاً له، أرصد ثلثها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لمصالح القدس، وأقطع ابنه عماد الدين هذا بقيتها، فلم يزل قائم الجاه من الأيام الصلاحية، فاتفق عماد الدين مع جماعة من الأكراد والجند على خلع الملك الكامل، وتمليك أخيه الفائز إبراهيم، ليصير لهم التحكم في المملكة، ووافقه على ذلك الأمير عز الدين الحميدي، والأمير أسد الدين الهكاري، والأمير مجاهد الدين، وعدة من الأمراء. فلما بلغ الكامل ذلك دخل عليهم، فإذا هم مجتمعون، وبين أيديهم المصحف، وهم يحلفون لأخيه الفائز، فعندما رأوه تفرقوا، فخشي على نفسه منهم، وخرج “.
ويستفاد من هذا الخبر أنه كان في الدولة تياراً معارض لأن يكون الكامل هو السلطان بعد أبيه العادل، ويستفاد أيضاً أن قادة ذلك التيار هم من الأمراء الكرد، وينتمي أولئك الأمراء إلى قبيلتين كرديتين كبيرتين هما (هكّاري) و(حميدي)، ولم يكونوا حديثي النعمة في الدولة الأيوبية، وإنما كان لهم فيها تراث عريق، يرجع إلى عهد صلاح الدين وانتصاراته الكبرى على الفرنج.
والسؤال هو: لماذا وقف هؤلاء الأمراء الكرد ضد الكامل؟
كان تفسير المقريزي هو أن الأمراء أرادوا إزاحة الكامل عن سدة الحكم، و”تمليك أخيه الفائز إبراهيم، ليصير لهم التحكم في المملكة“. وهذا يعني أن هذا التيار- وهو كردي كما مر- كان قد خسر نفوذه في الدولة ليس في عهد الكامل فقط، وإنما في عهد والده العادل أيضاً، والدليل أنهم باشروا حركة التغيير بعيد وفاة العادل بمدة قصيرة، ويفيد هذا الخبر أيضاً أن قادة ذلك التيار كانوا يحاولون القيام بانقلاب داخل هرم السلطة الأيوبية، لإيصال الفائز ابن العادل إلى منصب السلطنة، وليستعيدوا من ثم نفوذهم في مركز صناعة القرار.
وثمة سؤال آخر: من الذي كان قد سيطر على مركز صنع القرار؟
وبعبارة أخرى: من الذي كان يتحكّم في الدولة الأيوبية؟
هذا أمر لا يقف عنده المؤرخون القدماء بروية وباهتمام كاف، ولا ندري هل كان السبب هو طريقتهم الانتقائية في اختزال سرد بعض الأحداث، والاسترسال في سرد أحداث أخرى؟ وإذا كان هذا هو السبب فلنا أن نتساءل مرة أخرى: ما هي المعايير التي كانوا يبنون عليها طريقتهم الانتقائية؟ هل كان من تلك المعايير معيار (الدنيا مع القائمين) مثلاً؟ وهل كان استفحال النفوذ المملوكي في الدولة الأيوبية، وهيمنتهم على الأمور كلية بعدئذ، من العوامل التي جعلت المؤرخين يغيّبون بعض المعلومات، ويفرجون عن بعضها الآخر؟ كل ذلك ممكن، ومع ذلك لا يمكننا معرفة الأسباب الحقيقة بجلاء ما لم نعد إلى الوراء بضعة عقود، ونبدأ في تفحّص الأمر منذ نشأة الدول الزنكية نفسها.
تنافس كردي – تركماني
كانت الدولة الزنكية تركمانية لكن بجغرافيا كردية، وبموارد كردية، وبقدرات عسكرية نصفها كردية على أقل تقدير، ولا سيما بعد أن انضمت الأسرة الأيوبية إلى صف عماد الدين زنكي، ووظفت قدراتها وقدرات من معها من فرسان الكرد في الخطط الحربية الزنكية، وفي تحقيق الانتصارات، وتوسيع حدود الدولة شمالاً في كردستان، وغرباً في بلاد الشام، بل لولا جهود الأخوين أيوب وشيرگوه لما وصل نور الدين إلى الحكم بعد مقتل والده عماد الدين سنة (541 هـ/1146 م)، ولما تمكن بعدئذ من السيطرة على دمشق، واتخاذها قاعدة في حروبه ضد الفرنج.
ولولا سيطرة الزنكيين على دمشق وجنوبي بلاد الشام عموماً، بجهود كردية طبعاً، لما استطاعت القوة الزنكية أن تتحول إلى قوة إقليمية فاعلة، توازن القوى الإقليمية الأربع الأخرى في المنطقة حينذاك: الدولة البيزنطية وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى، والفرنج في ساحل بلاد الشام، والفاطميون في مصر.
ويكفي للتدليل على النشاط الكردي في الدولة الزنكية أن نور الدين أوكل إلى شيرگوه مهمة قيادة الجبهة الغربية (منطقة حمص) في مواجهة الفرنج، وكانت من أخطر الجبهات حينذاك؛ يقول البُنْداري في كتابه (سنا البرق الشامي، ص 24):
” ولما كان ثغر حمص أخطر الثغـور تعيّن أسـد الدين لحمايته وحفظه ورعايته، لتفرّده بجـدّه واجتهـاده وبأسـه وشجاعته “.
والدليل أيضاً أن نور الدين كلّف القائد الكردي شيرگوه، وليس قائداً تركمانياً، بقيادة ثلاث حملات على مصر، لإيقاف الخطر الفرنجي، وأن فارساً كردياً، وليس تركمانياً، هو الذي ضحّي بنفسه سنة (558 هـ)، وأنقذ السلطان نور الدين زنكي من موت محقق على أيدي الفرنج، حينما فاجأت قوة فرنجية معسكره قرب حصن الأكراد في منطقة حمص السورية (انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 11/294 – 295).
وبعد وفاة نور الدين، وقيام الدولة الأيوبية بجهود صلاح الدين، كان من الطبيعي أن يزداد النفوذ الكردي في الدولة، وخاصة على صعيد صناعة القرارات الكبرى، وهذا أمر لم يكن يرضي القادة التركمان، ولو تتبعنا الظروف التي تلت وفاة شيرگوه في مصر، وتنصيب صلاح الدين خليفة له في قيادة الجند الشامي، وفي تولّي منصب الوزارة للدولة الفاطمية، لوجدنا أن كبار قادة التركمان كانوا معارضين أشد المعارضة لتلك الإجراءات، بل إن بعضهم ترك مصر غاضباً، وعاد على بلاد الشام.
ولو تتبعنا ما كان يدور خلف الستار حينذاك؛ لوجدنا أن الفقيه الكردي المقاتل ضياء الدين عيسى الهكّاري هو الذي وحّد الفريق الكردي في مواجهة الفريق التركماني، وهو الذي أقنع كبار أمراء الكرد المنافسين لصلاح الدين بضرورة التخلي عن موقف المعارضة، والوقوف إلى جانب صلاح الدين باعتباره كردياً مثلهم، وإلا لخرج الأمر من أيدي الكرد، وخسر الجميع.
ما أريد قوله هو أن أكبر قوتين ضاربتين، في العهدين الزنكي والأيوبي، كانت القوة الكردية والقوة التركمانية، وكان ثمة صراع خفي يدور بين الفريقين، وكان ذلك الصراع يتجلى في مواقف كبار الأمراء والقادة، وكان يشتد تارة ويخفّ تارة أخرى، لكن شخصية نور الدين التوفيقية والمهيبة كانت كفيلة بتخفيف حدة التنافس.
على أن نور الدين نفسه لم يستطع الاحتفاظ بموقفه التوفيقي إلى النهاية، فقد نجح الفريق التركي في أن يجعله طرفاً في ذلك التنافس، ولا سيما حينما تمكّن الكرد من الهيمنة على مصر بقيادة البيت الأيوبي، وأحسب أنه لو عاش نور الدين بضع سنوات أخرى لنشب الصراع بين المعسكرين الأيوبي والزنكي، ولتغير مجرى التاريخ، ولما تم استرداد القدس من أيدي الفرنج.
وبعد وفاة نور الدين نشبت الخلافات داخل الفريق الزنكي، وسيطر صلاح الدين على مقاليد الأمور في مصر والشام، وأسس الدولة الأيوبية، واستكمل مشروع تحرير بلاد الشام من الفرنج، ولم يشأ إخراج القوة التركمانية المقاتلة والمتمرسة من دائرة الصراع، وصحيح أنه حشد أبناء القبائل الكردية، ودفهم إلى الانخراط في الصراع الإسلامي الفرنجي، وزجّ بهم في خط الدفاع الأول، لكنه كان أذكى من أن يهمل القدرات القتالية الرفيعة للمقاتلين التركمان، واستطاع بشخصيته التوفيقية أن يقيم نوعاً من التوازن بين الفريقين الكردي والتركماني، ” وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك، والأتراك لا يدينون للأكراد ” حسبما قال بعض كبار قادة المماليك سنة (588 هـ) خمسمئة وثمان وثمانين (انظر أبو شامة: عيون الروضتين: 2/268).
سيكولوجيا الجبال
إن روح التمرد الكامنة في قرارة النفس الكردية، والنزوع إلى التنافس، إضافة إلى سيكولوجيا الجبال المتأصلة في شخصية الكردي، ومن مظاهرها: العناد، والتمترس في الموقف، والاعتداد بالذات، وروح الصلف، وصعوبة انقياد الكردي للكردي، أقول: إن هذه العوامل جميعها كانت تجعل التعامل مع المقاتلين الكرد صعباً، وثمة أكثر من موقف يؤكد أن بعض الأمراء الكرد، ومنهم الجَناح أخو سيف الدين المشطوب، كانوا يعاملون صلاح الدين معاملة الند للند، وكانوا يخاطبونه بكلام خشن، ويواجهونه بما لا يجرؤ الآخرون على مواجهته به، فيأخذهم بالحلم، ويغضّ النظر عن تطاولهم عليه (انظر أبو شامة: عيون الروضتين: 2/317).
أما الترك فهم أبناء ثقافة سهوب آسيا الوسطى، ثقافة الجغرافيا المفتوحة، الجغرافيا التي تسهّل السيطرة على الآخر بالقوة، وهي الجغرافيا التي لا بد فيها من التكتل القبلي، والانقياد للزعيم حفاظاً على الوجود، إن سيكولوجيا السهوب هذه أصّلت في الشخصية التركية روح طاعة القائد، وإن هذه المزية في المقاتلين الترك جعلت الجهات الحاكمة، ومنها الدولة الأيوبية، تجنّدهم على شكل مماليك، وقد شكّل شيركوه، فرقة المماليك الأسدية، نسبة إلى لقبه (أسد الدين)، وشكّل صلاح الدين فرقة المماليك الصلاحية، نسبة إلى لقبه (صلاح الدين).
وكان المماليك الترك يلتزمون طاعة سادتهم؛ ما دام أولئك السادة أقوياء، لكنهم كانوا يتسلطون على مقاليد الأمور، بعد أن يكثر عددهم ويزداد نفوذهم، وخاصة في عهود القادة الضعفاء، ففي العصر العباسي كان المماليك الأتراك ملتزمون جداً في عهد كل من المأمون والمعتصم والواثق، لكنهم سرعان ما تآمروا على المتوكل، وفتكوا به، وتسلّطوا على شؤون الخلافة من وراء الستار.
وحدث الأمر نفسه في الدولة الأيوبية، فبعد وفاة صلاح الدين ازداد اعتماد ملوك بني أيوب على المماليك الأتراك، واستعان به كل فريق لإزاحة الفريق الآخر عن طريقه؛ فهذا الملك الأفضل ابن صلاح الدين يخرج من مصر، وكان وصياً على ابن أخيه السلطان المنصور ابن السلطان العزيز، متوجهاً إلى بلاد الشام، لمواجهة عمه العادل، ” واستخلف على القاهرة سيف الدين يازكج الأسدي “، ويازكج هذا مملوك تركي، واستخلاف مملوك تركي بدل من أمير كردي في عاصمة السلطنة دليل واضح على تنامي قوة الترك، وتراجع قوة الكرد (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 179).
وإن قادة المماليك الصلاحية والمماليك الأسدية هم الذين رجّحوا كفة الملك العادل؛ خلال صراعه ضد ابن أخيه الملك الأفضل بن صلاح الدين، وإن قادة فرقة الأسدية هم الذي أيّدوا الملك العادل في خلع السلطان الصبي المنصور ابن السلطان العزيز، والحلول محله في منصب السلطنة؛ وثمة شواهد أخرى عديدة على رجحان كفة المماليك الأتراك، وهبوط كفة التيار الكردي.
وكان من الطبيعي أن ينقم الأمراء الكرد على سياسة ملوك بني أيوب هذه، ولا سيما أن الكرد هم الذين أسهموا في تأسيس الدولة الأيوبية، وكانوا وقود المعارك الأكثر ضراوة ضد الفرنج، وكانوا يعلمون أن إبعاد الكرد عن مركز صناعة القرار، وتغليب المماليك، يعني في النهاية سيطرة الترك على كل مفاصل الدولة؛ وتؤكد الأحداث اللاحقة في عهد السلطان الصالح نجم الدين، وعهد ولده السلطان توران شاه، أن الزعماء الكرد كانوا على صواب كبير في تحليلهم هذا، فقد تآمر كبار قادة المماليك الترك على السلطان توران شاه، وقتلوه غدراً، وقضوا على الدولة الأيوبية، وأسسوا دولة المماليك الأتراك.
قراءة أخرى
أحسب أن هذه الإضاءات جعلت المشهد السياسي متكاملاً، والرؤية واضحة، فالحركة التي قام بها الفريق الكردي بقيادة ابن المشطوب، بغية إزاحة السلطان الكامل عن الحكم، وإحلال أخيه الفائز محله، لم تكن مؤامرة عابرة، وإنما كانت حركة تصحيحية داخل البيت الكردي نفسه، وكانت الغاية إعادة الكرد إلى مركز صناعة القرار في الدولة الأيوبية، والحؤول دون سيطرة المماليك الترك على أمور الدولة، وعدم تمكينهم مستقبلاً من إسقاط الدولة جملة وتفصيلاً، وهذا ما فعله المماليك سنة (648 هـ / 1250 م)؛ أي بعد ثلاثة عقود فقط.
ويثير هذا الحدث أكثر من علامة استفهام، ومهما يكن فقد أخذ الكامل الأمر مأخذ الجد، وخشي على نفسه من أن يفتك به القادة الكرد، وكان أول خطوة قام بها هي أنه انسحب ليلاً من مركز القيادة في العادلية، وانتقل إلى أشمُوم طَنّاح، فدبّت الفوضى في الجيش الأيوبي، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 232):
” وأصبح العسكر وقد فقدوا السلطان، فركب كل أحد هواه، ولم يعرج واحد منهم على آخر، وتركوا أثقالهم وخيامهم وأموالهم وأسلحتهم، ولم يأخذ كل أحد إلا ما خف حمله، فبادر الفرنج عند ذلك، وعبروا دمياط وهم آمنون، من غير منازع، وأخذوا كل ما كان في عسكر المسلمين، وكان شيئاً لا يقدَّر قدره “.
وإنه لأمر غريب حقاً أن يقوم الكامل بهذه الخطوة المفاجئة، وهو السلطان الراجح العقل، والقائد الطويل التجربة، إذ كيف يهرب من ساحة المعركة، ويترك جيشه بلا قيادة، وهو يعلم أن ذلك معناه انتقال الفرنج من ضفة النيل الغربية إلى الضفة الشرقية، والنزول أمام دمياط مباشرة؟! وكيف يفعل ذلك وهو يعلم أن سيطرة الفرنج على دمياط معناه أن الطريق إلى القاهرة، عاصمة السلطنة، بات مفتوحاً؟!
إن وراء الأكمة ما وراءها كما يقول المثل، وللمؤرخين أن يعرضوا الحدث بالكيفية التي يرونها، ولنا أن نكون أكثر رويّة ونتساءل: لماذا حدث الأمر على هذا النحو؟ أيعقل أن يعمد سلطان إلى الفرار من معسكره بهذه الطريقة الفجّة؟! أما كان من المنطقي والحال هذه أن يتقوّى بجنوده والمناصرين له من كبار القادة؟!
بلى، هذه تساؤلات جديرة بأن تثار.
والذي نراه أن قادة الجناح التركي استكملوا اللعبة، أقصد لعبة السياسة والسلطة، فبعد أن أوهموا السلطان بأنه مهدد بالعزل، وربما بالقتل من قبل الفريق الكردي، اقترحوا على السلطان الابتعاد عن مسرح المؤامرة، والأرجح أن السلطان أوكل إليهم أمر قيادة الجيش، لكن قادة الجناح التركي انسحبوا أيضاً من مركز القيادة، ليبقوا على مقربة من السلطان، وليرصدوا كل حركة من حركاته.
أقول هذا ترجيحاً، وأبني هذا الترجيح على دليل من تاريخ المماليك أنفسهم في معركة المنصورة؛ فبعد حوالي خمسة وثلاثين (646 هـ/1248 م) شن الملك الفرنسي لويس التاسع الحملة الصليبية السابعة على مصر، وعلى دمياط تحديداً، وكان السلطان الصالح ابن السلطان الكامل مريضاً، فاضطر إلى أن ينسحب إلى أشموم طنّاح، فشرع قادة المماليك يتسقّطون أخباره، ولما توهّموا أنه مات انسحبوا بالجيش إلى أشموم طنّاح، سعياً إلى السلطة، وتركوا الجسر كما هو، فعبر عليه الفرنج بسهولة، ولما رأى أهل دمياط أن الجيش السلطاني قد انسحب فروا من مدينتهم حفاة، لا يلوون على شيء، وحلّت الكارثة الكبرى.
ترتيبات جديدة
ولنعد إلى متابعة أحداث حصار دمياط.
فبعد أن عبر الفرنج نهر النيل، وسيطروا على المعسكر الأيوبي، أصبح موقف السلطان الكامل ضعيفاً جداً، ووصف المقريزي موقفه قائلاً: ” فتزلزل موقف الملك الكامل، وهمّ بمفارقة مصر، ثم تثبّت “، فالتحق به الجنود، ووافاه أخوه الملك المعظَّم حاكم دمشق، فقويت شوكته به، واتفق الأخوان على إبعاد كل من الملك الفائز والأمير ابن المشطوب؛ أما الفائز فأُبعد إلى كردستان، باعتباره رسولاً من الكامل إلى أخيه الملك الأشرف، يطلب منه النجدة، وأما ابن المشطوب فأفلح المعظّم في عزله من أنصاره الكرد، وإبعاده إلى بلاد الشام، (انظر المقريزي: السلوك:، ج1، ق1، ص 233).
أما الفرنج فأقاموا معسكرهم في الجانب الشرقي، وحصّنوه تحصيناً متيناً، وحفروا حوله خندقاً، وبنوا له سوراً، وحاصروا دمياط من البر والبحر، وضيّقوا على من فيها، وكانوا حوالي عشرين ألف مقاتل، إضافة إلى السكان، ومنع الفرنج وصول الإمدادات إليهم، ومع ذلك صبروا وقاتلوا أشد قتال، رغم قلة الأقوات وغلاء الأسعار، وشرع الكامل في محاربة الفرنج من جانبه، لكنه ظل عاجزاً عن التواصل مع المحاصَرين داخل دمياط، إلا بوساطة سبّاح من حَمْوي يدعى (شمايل)، كان ينقل الأخبار بين السلطان والمحاصَرين في الداخل.
ودخلت سنة (616 هـ) ستمئة وست عشرة هجرية ودمياط محاصرة، والحرب قائمة بين الكامل والفرنج، وقد هبّ بعض ملوك بني أيوب إلى نجدة الكامل، فقدم الملك المظفّر ملك حماة بعسكر كثيف، إلا أن الفرنج طوّروا الهجوم على دمياط، فقلّت المؤن، وحلّت المجاعة بين السكان، وبعد حصار دام ستة عشر شهراً، تسوّر الفرنج سور المدينة، واقتحموها، ووضعوا السيف في أهلها، وأسرفوا في القتل، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 237):
” وحصّن الفرنج أسوار دمياط، وجعلوا جامعها كنيسة، وبثّوا سراياهم في القرى يقتلون ويأسرون، فعظم الخطب، واشتد البلاء، وندب السلطان الناس، وفرّقهم في الأرض، فخرجوا إلى الآفاق يستصرخون الناس، لاستنقاذ أرض مصر من أيدي الفرنج “.
وراح كل فريق يعزز موقعه العسكري، ويعدّ للخطوة التالية.
أما السلطان الكامل فإنه شرع يجمع المقاتلين، ويطلب النجدات والإمدادات من بلاد الشام وكردستان، وأقام في الوقت نفسه معسكراً جديداً في الموقع الذي سُمّي بعدئذ باسم مدينة (المنصورة)، وزوّده بالمرافق اللازمة للإقامة الطويلة، مثل الدور، والفنادق، والحمّامات، والأسواق.
وأما الفرنج فإنهم كانوا يعزّزون موقفهم العسكري باستمرار، وكان المقاتلون ينضمون إليهم قادمين من بلدان أوربا، وقد خرجوا من دمياط يريدون احتلال القاهرة عاصمة السلطنة، ونزلوا مقابل معسكر السلطان الكامل، ولم يبق أمامهم إلا تحقيق النصر على جند الكامل، وإزاحتهم من الطريق، والوصول إلى القاهرة، بل إنهم كانوا واثقين من السيطرة على مصر، حتى إن ملكهم كان قد وزّعها مسبقاً على قادة جنده بصورة إقطاعات؛ قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 239):
” وخرجت أمم الفرنج من داخل البحر، تريد مدد الفرنج على دمياط، فوافى دمياط منهم طوائف لا تحصى، فلما تكامل جمعهم بدمياط خرجوا منها، في حدّهم وحديدهم، وقد زيّن لهم سوء عملهم أن يملكوا أرض مصر، ويستولوا منها على ممالك البسيطة كلها “.
ولم يكتف الفرنج بالهجوم على مصر، وإنما فتحوا الجبهة الشرقية في بلاد الشام ضد الأيوبيين، ليشتّوا قواهم وجهودهم، وحاولوا مهاجمة القدس واحتلالها ثانية، وكانت الخطط الحربية تقضي بألا تدع العدو يستفيد من دفاعاتك وتحصيناتك ومعدّاتك الحربية حينما تجد نفسك مضطراً إلى التراجع، وهذا ما فعله الملك المعظّم حاكم دمشق، فأمر بتخريب أسوار القدس وأبراجها كلها، عدا برج واحد في غربي البلد، ونقل ما كان في القدس من الأسلحة وآلات القتال، وخرج معظم الناس من المدينة، خوفاً من الفرنج، ” فشقّ على المسلمين تخريب القدس وأخذ دمياط “. (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 240).
المعركة الفاصلة
والأدهى أن الجبهة الداخلية في مصر تعرّضت مرة أخرى لانتكاسة خطيرة، فقد استغل أهل الأرياف ضعف موقف السلطان أمام الفرنج، فأثاروا الاضطرابات في وجهه، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 237): ” فإنه كان قد كثر تسلّطهم، وطمعوا في أمر السلطان، واستخفّوا به، لشغله بالفرنج عنهم “. وهنا أعلن السلطان النفير العام في البلاد، وطلب من الجميع أن يهبّوا للدفاع عن مصر، فانضم إلى صفه عدد كبير من المقاتلين.
وفي الوقت نفسه هبّ إلى نجدته جميع ملوك بني أيوب في بلاد الشام وكردستان: الملك المنصور صاحب حماة، والملك المجاهد صاحب حمص، والملك الأمجد بهرام شاه صاحب بعلبك، وأخوه الملك الأشرف حاكم كردستان والمناطق المتاخمة لها من أرمينيا، وكان يدعى (شاه أرمن)، وسبق القول بأن أخاه الملك المعظّم صاحب دمشق كان قد جاء إلى نجدته بجنوده، وبلغ عدد فرسان الجيش الأيوبي نحو أربعين ألفاً.
وحلّت سنة (618 هـ) ستمئة وثماني عشرة هجرية والحرب على قدم وساق بين الأيوبيين والفرنج، بل يمكننا القول: إنها كانت حرباً كبرى بين الشرق ممثلاُ في القيادة الأيوبية، وبين الغرب (أوربا) ممثلاً في الفرنج، وقد وصف المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 243) ضخامة عدد المقاتلين من كل فريق بقوله: ” واشتد القتال بين الفريقين براً وبحراً، وقد اجتمع من الفرنج والمسلمين ما لا يعلم عددهم إلا الله “.
وكان السلطان الكامل قد استثمر التعزيزات التي وصلته، فوضع خطة حربية جديدة، كانت نتيجتها قطع المؤن والإمدادات عن الفرنج من البر والبحر، والانقضاض على سفنهم الحربية، وهي التي كانت تنقل إليهم الإمدادات، وأسروا منهم ألفين ومئتي مقاتل، ” ثم ظفروا أيضاً بثلاث قطائع [ربما هي قطع حربية، أو كتائب]، فتضعضع الفرنج لذلك، وضاق بهم المقام، وبعثوا يسألون في الصلح “. (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 239).
وفي أوج احتدام القتال كان الفرنج يرسلون وفودهم للمباحثة في الصلح، وكان من شروطهم أن يستردوا القدس وعسقلان وطبرية في فلسطين، وجَبلة واللاذقية على الساحل السوري، وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين سابقاً. وقد وافق الجانب الأيوبي على ذلك، ما عدا قلعتي الكَرَك والشُّوبك، باعتبار أن سيطرة الفرنج على هاتين القلعتين في جنوبي الأردن كان يعني قطع طرق المواصلات بين جناحي الدولة الأيوبية؛ الجناح الغربي ممثلاً بمصر، والجناح الشرقي ممثلاً ببلاد الشام وكردستان، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 243):
” فأبى الفرنج، وقالوا: لا نسلّم دمياط حتى تسلّموا ذلك كله. فرضي الكامل، فامتنع الفرنج، وقالوا: لا بد أن تعطونا خمسمئة ألف دينار، لنعمر بها ما خرّبتم من أسوار القدس، مع أخذ ما ذكر من البلاد، وأخذ الكرك والشوبك أيضاً “.
وهكذا كان الفرنج يتشدّدون في شروطهم، ويطلبون كل شيء مقابل انسحابهم من دمياط، لكن الفريق الأيوبي لم يرضخ للفرنج، واستمر في القتال والمصابرة، ولجأت القيادة الأيوبية إلى تكتيك جديد ما كان الفرنج قد أعدّوا العدّة لمواجهته؛ ألا وهو إغراق الأرض المحيطة بمعسكر الفرنج بمياه النيل، وإعاقة تحركاتهم. وقد نجح فريق من الجيش الأيوبي في فتح ثغرة كبيرة في النيل، وكان الوقت وقت الفيضان، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 243):
” والفرنج لا معرفة لهم بحال أرض مصر، ولا بأمر النيل، فلم يشعر الفرنج إلا والماء قد غرّق أكثر الأرض التي هم عليها، وصار حائلاً بينهم وبين دمياط، وأصبحوا وليس لهم جهة يسلكونها، سوى جهة واحدة ضيقة “.
وقد أحكم السلطان الكامل خطة محاصرة الفرنج، وعزلهم براً وبحراً، فأمر الجند بنصب الجسور، والعبور للسيطرة على الطريق الضيقة التي كانت تصل الفرنج بدمياط، وفي الوقت نفسه وصلت سفينة حربية ضخمة جداً إلى ساحل دمياط، تحمل الميرة والسلاح إلى الفرنج، وتحرسها حرّاقات (زوارق حربية) عديدة، فهاجمتها السفن الحربية الأيوبية، وسيطر الفريق الأيوبي على السفينة وعلى ما فيها وما معها من الحرّاقات، الأمر الذي فتّ في عضد الفرنج، وأوقع في نفوسهم الرعب، وأصبحوا محاصرين من جميع الجهات.
ورغم هذا الموقف العسكري الصعب جداً لم يستسلم الفرنج، واجتمع رأيهم على مناهضة الجيش الأيوبي، والوصول إلى دمياط، ” فخرّبوا خيامهم ومجانيقهم، وعزموا على أن يحطموا [يهجموا] حطمة واحدة، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً، لكثرة الوحل والمياه التي قد ركبت الأرض من حولهم، فعجزوا عن الإقامة لقلة الأزواد عندهم، ولاذوا إلى طلب الصلح، وبعثوا يسألون الملك الكامل، وإخوته الأشرف والمعظّم، الأمان لأنفسهم، وأنهم يسلّمون دمياط بغير عوض ” (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 244).
إنه لانقلاب كبير في الموقف العسكري ولا ريب، تطلّب من القيادة الأيوبية اتخاذ قرار حاسم، وكان من الطبيعي أن تختلف الآراء، وكان رأي السلطان الكامل هو الموافقة على ما طلبه الفرنج، ورأى إخوته الاستمرار في القتال، ” واجتثاث أصلهم البتّة “، فلا تقوم لهم قائمة بعدئذ.
لكن العبقرية الحربية والسياسية لا تقع تحت تأثير شهوة الانتقام، وإنما تأخذ جميع الظروف والاحتمالات بعين الاعتبار، أفلم يكن الفرنج في موقف قوي؟! أولم يكن الفريق الأيوبي على وشك الهزيمة؟! إذاً ما الذي يمنع من أن يستعيد الفرنج زمام المبادرة ثانية؟! ولا سيما أن لهم أعداداً غفيرة من المقاتلين في دمياط، وأن الإمدادات تنهمر عليهم من أوربا، وأن الغضب يأكل ملوك أوربا بسبب مقتل كثير من كبرائهم؟
ثم أليس من واجب السلطان أن يأخذ أحوال جنوده في الحسبان أيضاً؟ فقد ظل هؤلاء المقاتلون يخوضون المعارك العنيفة طوال ثلاث سنين وأشهراً، فهل من العجب أن يتسلل الضجر إلى نفوسهم؟! أليس من حقهم الفوز ببعض الراحة، والعودة إلى أهليهم؟!
لقد نظر الكامل إلى الموقف نظرة شمولية، مراعياً معطيات الداخل والخارج، وآخذاً في الحسبان الجوانب المادية والمعنوية، ووضع كل هذه الحقائق أمام القيادة الأيوبية المشتركة، فوافقه إخوته على طلب الأمان الذي سعى إليه الفرنج، شريطة أن يرسلوا رهائن من ملوكهم وليس من أمرائهم، واشترط الفرنج بالمقابل أن يرسل السلطان ابنه الملك الصالح نجم الدين رهينة عندهم إلى أن تعود رهائنهم، “فتقرر الأمر على ذلك، وحلف كل ملك من ملوك المسلمين والفرنج“.
وأرسل الفرنج عشرين ملكاً من ملوكهم رهائن، منهم يوحنا صاحب عكا، ونائب البابا، وأرسل السلطان ابنه الملك الصالح إليهم، وله من العمر يومئذ خمس عشرة سنة، ومعه جماعة من خواصه، واستقبل السلطان ملوك الفرنج الرهائن في مجلس مهيب، وإخوته الملوك واقفون بين يديه، الأمر الذي دهش له الفرنجة، ثم جاء قساوسة الفرنجة ورهبانهم لتسليم دمياط، وتسلّمها الأيوبيون.
وسرعان ما ظهرت صحة وجهة نظر السلطان الكامل، وتأكّدت عبقريته الحربية والسياسة، ففي اليوم الذي تسلّم فيه الجيش الأيوبي دمياط وصلت نجدة عظيمة إلى الفرنج قادمة من أوربا، وكانت تتألف من حوالي ألف مركب، ولا ريب أنها لم تكن مراكب فارغة، وإنما كانت مشحونة بالرجال والأسلحة وسائر الإمدادات، ثم إن المسلمين، بعد دخولهم دمياط، وجدوا أن الفرنج كانوا قد قاموا بتحصينها تحصيناً شديداً جداً، إلى درجة أنه كان يستحيل استردادها بالقوة؛ فكيف كان سيصبح الموقف العسكري الفرنجي بعد وصول تلك المراكب؟! أما كان من الممكن أن يستعيدوا قوتهم، ويجعلوا الجيش الأيوبي في موقف أشد صعوبة مما سبق؟!
وبعد استرداد دمياط بعث الكامل بمن عنده من رهائن الفرنج، وقدم ابنه الملك الصالح ومن كان معه من عند الفرنج، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 245 – 246):
” وتقررت الهدنة بين الفرنج وبين المسلمين مدة ثماني سنين، على أن كلاً من الفريقين يطلق ما عنده من الأسرى، وحلف السلطان وإخوته، وحلف ملوك الفرنج، على ذلك، وتفرق من كان قد حضر للقتال، فكانت مدة استيلاء الفرنج على دمياط سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، ثم دخل الملك الكامل إلى دمياط بعساكره وأهله، وكان لدخوله مسرة عظيمة وابتهاج زائد، ثم سار الفرنج إلى بلادهم “.
وهنّا الشعراء السلطان بقصائد بديعة، فقال شرف الدين ابن عنين في قصيدة له:
سلوا صَهَوات الخيل يومَ الوغى عنا
إذا جهلت آياتنـا والقنـــا اللُّدْنا
غداةَ التقينا دون دميـــاط جَحْفَلاً
من الروم لا يُحصى يقيناً و لا ظنّا
قد اجتمعوا رأياً ودينـاً وهمّـــةً
وعزمـاً، وإن كانوا اختلفـوا سنّا
فما برحتْ سُمْرُ الرماح تُنوشهمْ
بأطرافها، حتى استجاروا بنـا منّا
بدا الموت من زُرق الأسنّة أحمراً
فألقوا بأيديهـم إلينــا، فأحسنّا
الحملة الصليبية السادسة
ذات مرة قال القاضي الفاضل في الأيوبيين:
” الآباء اتفقوا فملكوا، والأبناء اختلفوا فهلكوا “.
والحقيقة أن هذا القول يصح على قادة الكرد وزعمائهم عبر كل العصور، فقد اتفق أبناء السلطان العادل على التصدي للحملة الصليبية الخامسة، فألحقوا بها الفشل، لكن سرعان ما ” عادت حليمة إلى عادتها القديمة “؛ كما يقول المثل العربي القديم، ونشبت الخلافات من جديد بين الإخوة الثلاثة: السلطان الكامل صاحب مصر، والملك المعظّم صاحب دمشق، والملك الأشرف صاحب كردستان وما يجاورها من بلاد أرمينيا، وكان الخلاف الرئيس بين كل من المعظم والأشرف يدور حول حماة وحلب الواقعة بين منطقتي نفوذيهما، وكان لا بد للسلطان الكامل من التدخل كل مرة، للوقوف إلى جانب الطرف المظلوم.
ومع سنة (623 هـ) كان الشقاق بين الإخوة الثلاثة قد بلغ الذروة، ووقف المعظم والأشرف معاَ ضد الكامل، وشرع المعظم صاحب دمشق يراسل السلطان جلال الدين خوارزم شاه، طالباً منه النجدة على أخيه السلطان الكامل، “ووعده أن يخطب له، ويضرب السكّة باسمه، فسيّر إليه جلال الدين خلعة لبسها، وشقّ بها دمشق، وقطع الخطبة للملك الكامل” (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1،ص 259)، وكان جلال الدين حينذاك قد تراجع أمام الزحف المغولي، ووصل إلى أذربيجان وكردستان، وبالمقابل بحث الكامل عن نصير يستعيد به توازن القوى ضد أخويه، فوجد بغيته في صديقه فردريك الثاني إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة، فشجّعه على مهاجمة سواحل بلاد الشام، حيث ممتلكات أخيه الملك المعظم.
أما في الجانب الأوربي فكان الألماني فردريك الثاني قد تعهّد للبابوية، إبّـان وصوله إلى السلطة سنة (1214م)، أن يقوم بحملة صليبية لاسترداد القدس، وفي سنة (1220م) تُوّج إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة في كنيسة القديس بطرس بروما، بعد أن جدّد العهد للبابوية بشنّ الحملة المتفق عليها.
ويبدو أن فردريك لم يكن جاداً في مشروعه الصليبي، فهو رجل واسع الاطلاع على الفلسفة، والعلوم، والطب، والتاريخ الطبيعي، ويجيد من اللغات الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واللاتينية، واليونانية، والعربية، وكانت له تعليقات مثيرة حول الأديان، ولم يكن متحمساً للحروب الدينية؛ في حين كانت البابوية تتوق إلى إرسال حملة صليبية سادسة على وجه السرعة لإصلاح الموقف الناجم عن فشل الحملة الصليبية الخامسة، وأدّت مماطلة الإمبراطور، وخلافاته مع البابا، إلى إصـدار قرار الحرمان ضده سنة (1227م).
ونتيجة لتأزّم الموقف أدرك الإمبراطور فردريك أن مصلحته السياسية تقتضي القيام بحملة صليبية، يفوّت بها على البابا إظهاره بمظهر المسيحي العاق، وبدأ حملته سنة (625 هـ/1228 م) متوجّهاً إلى عكا، وكان قد وضع ثقته في حليفه السلطان الكامل، وكان الملك المعظم قد توفي سنة (624 هـ)، وبوفاته زالت عقبة كبرى من طريق السلطان الكامل، فخرج بجيشه إلى بلاد الشام، وهدفه أن يسيطر على دمشق والقدس وغيرها من البلاد التي كانت تابعة للمعظم.
ونتيجة للواقع الجديد لم يعد الكامل بحاجة إلى قدوم الإمبراطور فردريك، لكن كانت الفرصة قد فاتته، ولم ير فردريك بداً من القيام بالحملة الصليبية السادسة، تحت ضغوط البابا، وتمكّن بعد مفاوضات طويلة ومضنية مع الملك الكامل من استرداد القدس سنة (626 هـ/1229م) سلماً وعلى نحو شكلي، ووصلت المفاوضات إلى حد أن الإمبراطور كان يبكي متوسّلاً إلى صديقه الملك الكامل أن يحقق له رغبته هذه، فقط ليردّ مكر البابوية إلى نحرها، وفي اللحظات الأخيرة اصطلح الكامل وأخوه الأشرف ثانية، قال ابن الأثير (الكامل في التاريخ، 12/483):
” فلما اجتمعا تردّدت الرسل بينهما وبين الأنبرور، ملك الفرنج، دفعات كثيرة، فاستقرت القاعدة على أن يسلّموا إليه البيت المقدس، ومعه مواضع يسيرة من بلاده، ويكون باقي البلاد، مثل الخليل، نابلس، والغَور، ومَلَطْية [كذا، ولعلها: سَبَسْطية]، وغير ذلك بيد المسلمين، ولا يسلّم إلى الفرنج إلا البيت المقدس والمواضع التي استقرت معه، … وتسلّم الفرنج البيت المقدس، واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه، ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه “.
وأورد المقريزي أخبار المحادثات بين وفد السلطان الكامل والإمبراطور فردريك على نحو أكثر تفصيلاً مما أورده ابن الأثير، وخلاصة ما أورده أن رئيس الوفد المفاوض من الجانب الأيوبي كان فخر الدين بن شيخ الشيوخ، ومعه الشريف شمس الدين الأرموي قاضي العسكر، وقضت الاتفاقية أن الإمبراطور يأخذ القدس، لكن يبقيها على حالها، ولا يجدد سورها، وأن تكون سائر قرى القدس في أيدي المسلمين، لا حكم للفرنج فيها، وأن الحرم، بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى، يكون في أيدي المسلمين، لا يدخله الفرنج إلا للزيارة فقط، ويتولّى المسلمون شؤونه، ويقيمون فيه الأذان والصلاة، وكانت مدة الاتفاقية عشر سنين وخمسة أشهر وأربعين يوماً، ” واعتذر ملك الفرنج للأمير فخر الدين بأنه لولا انكسار جاهه ما كلّف السلطان شيئاً من ذلك، وأنه ما له غرض في القدس ولا غيره، وإنما قصده حفظ ناموسه عند الفرنج ” (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1، 269).
وبعد توقيع الاتفاقية استأذن الإمبراطور في دخول القدس، فأجابه الكامل إلى ما طلب، وكلّف قاضي نابلس بمرافقته، وطاف الإمبراطور في أرجاء المسجد الأقصى، وأعجب به، ورأى قسيساً بيده الإنجيل، وقد قصد دخول المسجد الأقصى، فزجره وأنكر مجيئه، وأقسم لئن دخل أحد من الفرنج المسجد بغير إذن ليقتلنه، وقال: ” فإنما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدّق علينا وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام، فلا يتعدّى أحد منكم طوره “، فانصرف القس وهو يرتعد خوفاً منه (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1، 269).
زمنان مختلفان
وصحيح أن اعتراف الكامل بدخول القدس في حكم الإمبراطور كانت صفقة سياسية شكلية الطابع، وأنه كان مكرهاً على ذلك بسبب ضعف موقفه، وقوة الإمبراطور ومن وروائه قوة أوربا، وصحيح أيضاً أن الإمبراطور نفسه لم ينظر إلى الأمر على أنه انتصار للمسيحية على الإسلام، ويبدو من سيرته الذاتية أنه كان علماني الرؤية، لا يتعصّب لدين ضد آخر، ومع ذلك فقد وقع خبر دخول القدس في حكم الفرنج على المسلمين كالصاعقة، ” فاشتد البكاء، وعظم الصراخ والعويل، وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيّم الكامل، وأذّنوا على بابه في غير وقت الأذان، فعزّ عليه ذلك، … واشتد الإنكار على الملك الكامل، وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار ” (انظر المقريزي: السلوك، ج1، ق1، 269).
ولسنا الآن بصدد تبرير تنازل السلطان الكامل عن القدس للإمبراطور فردريك، فثمة عوامل عديدة ساهمت في إيصال الكامل إلى اتخاذ ذلك القرار؛ أهمها تشرذم الأيوبيين وتخاصمهم، وتفرق قيادات شعوب شرقي المتوسط، وانشغال كل فئة بما يواجهها من تحديات، وبما يراودها من مصالح ومطامع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قياس الواقع العام في عهد الكامل بما كان عليه في زمن نور الدين وصلاح الدين؛ فقد أفلح هذان الزعيمان في تعبئة شعوب شرقي المتوسط، وتوظيف مواردها ضد الغزو الفرنجي، فكانا غير مضطرين إلى الخضوع لنهج الواقعية السياسية، وإنما كانا في موقف هجومي يصنعان من خلاله الواقع السياسي.
أما الكامل فإنه كان ينتمي إلى زمن الموقف الدفاعي، وليس إلى زمن الموقف الهجومي، وكان مضطراً من ثم إلى أن يأخذ بنهج الواقعية السياسية، ويرتّب الأولويات من جديد، ويضحّي بالقليل للاحتفاظ بالكثير، وينتظر الفرصة المناسبة لاسترداد ما فرّط فيه. وكانت الصداقة قد توثقت بينه وبين فردريك، وقطف ابنه الملك الصالح ثمرة تلك الصداقة بعدئذ، إذ كانت الأخبار التي يوصلها فردريك إلى السلطان الصالح سراً، حول تحركات الحملة الصليبية السابعة، من أكبر العوامل في فشل تلك الحملة، ونجاة مصر وشرقي المتوسط عامة من خطر كبير.
وقد أمضى السلطان الكامل الأعوام التالية في القضاء على المشكلات الداخلية، وأفلح في لملمة شمل أطراف الدولة ألأيوبية قدر المستطاع، فشرّق وغرّب، وعاد أخيراً إلى دمشق، فمرض وتوفي فيها سنة (635 هـ) وعمره نحو ستين سنة.
وتعبيراً عن وفاء الإمبراطور فردريك لصديقه الكامل أمر بالإفراج عن من عنده من الأسرى المسلمين، ” فأحضرهم الأمبرور بين يديه، وقال لهم: يا حجّاج، قد أعتقتكم عن الملك الكامل، وسيّرهم مع قصّاد تقودهم إلى عكا، وأمرهم بحل قيودهم عند قبره، وإطلاق سبيلهم ” (انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان، 5/91).
شخصية الكامل ومناقبه
تجمع كتابات المؤرخين على أن السلطان الكامل كان شخصية لا تخلو من التميّز في كثير من الميادين، وأول ما تميّز به هو ثقافته الواسعة، وحبه للعلم وأهله، ومشاركته في المناقشات العلمية، ورعايته للعلماء، وتوفير حياة كريمة لهم، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 300):
” وكان يحب أهل العلم، ويؤثر مجالستهم، وشغف بسماع الحديث النبوي، وحدّث بالإجازة من أبي محمد بن بري، وأبي القاسم البوصيري، وعدة من المصريين، وتقدم عنده أبو الخطاب بن دحية، وبنى له دار الحديث الكاملية بالقاهرة، وجعل عليها أوقافاً، وكان يناظر العلماء، وعنده مسائل غريبة من فقه ونحو يمتحن بها، فمن أجاب عنده قدّمه وحظي عنده، وكانت تبيت عنده بالقلعة جماعة من أهل العلم، كالجمال اليمني النحوي، والفقيه عبد الظاهر، وابن دحية، والأمير صلاح الدين الإربلي- وكان أحد الفضلاء- فينصب لهم أسرة ينامون عليها بجانب سريره، ليسامروه، فنفقت الآداب والعلوم عنده، وقصده أرباب الفضائل، فكان يطلق لمن يأتيه منهم الأرزاق الدارّة “.
رجل دولة قدير
أما على صعيد الإدارة والقيادة فقال ابن خلّكان(وفيات الأعيان، 5/89):
” خطب له إخوته وأهل بيته في بلادهم، وضربوا السكّة باسمه، وكان محبوباً إلى الناس، مسعوداً مؤيَّداً في الحروب “.
وقال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، 300 – 301):
” وكان مهيباً، حازماً، سديد الآراء، حسن التدبير لمماليكه، عفيفاً عن الدماء، وبلغ من مهابته أن الرمل – فيما بين العريش ومصر- كان يمر فيه الواحد بالذهب الكثير، والأحمال من الثياب، من غير خوف، وسُرق مرة فيه بساط، فأحضر الكامل العربان الذين يخفرون الطريق، وألزمهم بإحضاره وإحضار سارقه، فبذلوا عوضه شيئاً كثيراً وهو يأبى إلا إحضار السارق، أو إتلاف أنفسهم وأموالهم بدله، فلم يجدوا بداً من إحضار السارق والبساط “.
وأضاف المقريزي أيضاً (السلوك، ج1، ق1، 301):
” وكان يباشر أمور الملك بنفسه، من غير اعتماد على وزير ولا غيره، واستوزر أولاً الصاحب صفي الدين بن شكر ست سنين، … فلما مات الصاحب لم يستوزر بعد أحداً، بل كان يستنهض من يختار في تدبير الأشغال، … وصار يباشر أمور الدولة بنفسه، ويُحضر عنده الدواوين، فيحاققهم ويحاسب، وإذا ابتدأت زيادة النيل خرج بنفسه، وكشف الجسور، ورتّب في كل جسر من الأمراء من يتولاه، ويجمع الرجال لعمله، فمتى اختل جسر عاقب متوليه أشد العقوبة، فعمرت أرض مصر في أيامه عمارة زائدة “.
المراجع
- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1979م.
- البُنداري: سنا البرق الشامي، تحقيق فتحية النبراوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1979م.
- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1999م.
- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2006 م.
- أبو شامة: عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق أحمد البيسومي، وزارة الثقافة، دمشق، 1991 م.
- ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة الدكتور السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، 1980م.
- الدكتور السيد عبد العزيز سالم، الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2003 م.
- الدكتور عبد العظيم رمضان: الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الإسلام على انتهاء الحروب الصليبية، دار المعارف، القاهرة، 1983م.
- المقريزي: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، نشره محمد مصطفى زيادة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1971 م.
وإلى اللقاء في الحلقة التاسعة والثلاثين.
د. أحمد الخليل في 21 – 4 – 2007
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=35234