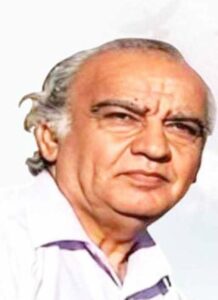سعيد يوسف
ليس دفاعاً عن جگرخوين، لأنّ جگرخوين ليس في الموقع الذي يحتاج فيه إلى مدافعين، فهو أرفع وأقوى من أن يُدافع عنه. فمثلما أنّ الشموع لا تزيد النجوم لمعاناً، كذلك فأنّ رميها بالجمرات لا ينال من بريقها.
نشر أحد الكتّاب في الآونة الأخيرة مقالاً تناول فيه جوانب من سيرة حياة المرحوم جگرخوين أحد أبرز رموز الساحة الثقافية الكوردية المعاصرة، تناوله بأسلوب القدح والذمّ وبطريقة انتقائيةٍ ضيقة ومبتذلة بحيث يخدم غرضاً محدّداً ومبيّتاً لديه وهو النيل من مكانته الاجتماعية عبر التسلّل من بوابة الدين كواحدة من أخطر مناطق المحرمات في عالم الشرق والتي يحظّر الاقتراب حتى من سياجها الدوغمائي المغلق. في حين أنّه أهمل التطرق إلى الجوانب المستنيرة والهامة في حياته : الثقافية منها والأدبية والوطنية وهذا ما يجعلنا نحكم بتهافت المقال وسقوطه.
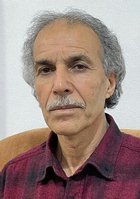
نعم الكتابة ولم لا..! فأبواب الميدياء المعاصرة مشرعةٌ أمام جميع الذين يتعاطون فعل الكتابة، التي سرعان ما تنتشر وبسرعة الضوء. حيث باتت سهلة ومباحة للجميع وعلى مختلف انتماءاتهم الثقافيّة وسويّاتهم الاجتماعية والأخلاقية قرّاءً وكتّاباً ومتقابسين…نقّاداً ومحللين…
واليكم الملاحظات التالية بخصوص نصّ المقال وشذرات أخرى :
أوّلاً : مشروعيّة النقد:
من حقّ أيّ كاتب دراسة النصوص ونقدها،
أيّ نصّ كان أدباً، تاريخاً، فلسفةً. ذلك لأنّ النصّ هو مساحة مشروعة للقراءة والنقد والتفسير والتأويل كما أنّه يتحوّل إلى ملك للقرّاء، ومن لا يقبل بذلك فعليه مغادرة الحقل الكتابي.
ومن شروط النقد وأدبياته أن يلتزم الناقد حدود النصّ ومايتعلّق به، وأن يكون موضوعياً سلباً وإيجابا، ويكون علميّاً منهجياً وأن يتحلى بالكياسة واللباقة، ليس فقط لجهة ما ينقد، بل كذلك لجهة منْ يقرأ. وما أثار دهشتي واستغرابي أن أحد الكتاب على صفحة “ولاته مى”. وصف مقالة جمال حمي بالنقد الموضوعي ومستنكراً تنمّر الآخرين عليه، بعد أنْ قام باجتزاء النص واختيار ما يلزمه فإذا به يبتعد عن الموضوعية أكثر من سلفه.
وقد يتناول الناقد الجوانب الشخصية في حياة شخصية ما ولكن دون تحامل..وأيّ تجاوز لما سبق قوله كاستعمال ألفاظ نابية ومهينة فذلك خروج على آداب النقد ومهنيته.
يصف الكاتب جگرخوين ب “هبل الكورد” ثم ينعته. ب “الفساد والإفساد” مرةً وسوء الخلق مرةً أخرى، وما يزيد السوء سوءاً، كون الرّجل راحلاً منذ عقود من الزمن…فهل القدح والذّمً يعتبران نقداً..؟ ثم ما الفائدة التي يمكن أن نجنيها من هذا الخطاب هذا إذا استحق صفة خطاب.
منذ البداية ركّز الكاتب على الجانب الديني في حياة جگرخوين، متّهماً إياه بالإلحاد والكفر والفساد في الأرض، وإفساد عقول الشباب. واتخاذه الماركسية منهجاً أو “مذهباً”. وما الغريب والمعيب في الأمر إنْ كان ماركسياً أو تمركس حيناً من الزمن، بكل الأحوال ذاك شأنٌ شخصي ولا ينال من إرثه الثقافي ونضاله الوطني.
ولعمري منْ من طلبة الكورد لم يكن ماركسيّا لينينياً، لقد كانت الماركسية موضة العصر، وخاصة بين الشباب الكورد الجامعيين في العقدين السابع والثامن من القرن الفائت. ولعلّهم وجدوا في ذلك منفذاً ومتنفّساً لهم عسى أن يحققوا من خلاله بصيص أمل من الحرية وبعضاً من الحقوق المهدورة، وأيّ عيب أن تكون ماركسيّاً، وشيوعيّاً سوى أنّ الأخيرة إستنزفت مزيداً من طاقات وجهود الشباب الكورد ومخلّفةً آثاراً سلبية أيضاً.
وإذا كانت الشيوعيه قد خيّبت آمال الكورد وبدّدت أحلامهم، فالأولى بنا أن نسأل ماذا قدّم الإسلام للكورد كونه الأقدم تاريخياً ولأنّ للكورد أفضالاً على الإسلام لا تعدّ ولا تحصى فهل أنصف الإسلام والمسلمون الكورد، وماذا كان جزاؤهم…؟
هذا الإنزلاق في النقد يحتمل عدّة تأويلات. فإمّا أنّنا أمام حالة عداوة قديمة، أوانتقام له خلفية تاريخية، أو أنّ الكاتب حقّاً مستغرق في الفكر الديني، و وصل به انتشاؤه الديني إلى حالة مرضية عصابية مما يعني أنّ العداوة فكرية. أوربما هناك دوافع متوارية، أو حوافز خفية خاصة بالكاتب وتوجّهاته الإسلاموية…؟
ثانياً- عقلية الإفتاء : سطوة المفهوم وعنف المضمون :
لكل دينٍ أو مذهب أو نظرية مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المتآزرة، التي تشكّل مع بعضها بعضاً ما يمكن أن نسميه نسقاً. مثلاً نجد في فلسفة افلاطون أو ارسطو مجموعة مفاهيم خاصة…وكذلك الحال بالنسبة للفلسفة الماركسية… وهكذا الوضع بالنسبة للأديان ومنها الإسلامي. ما أريد قوله أنّ كثيراً من مفاهيم تلك الفلسفات والأديان قد فقدت قيمتها الفكرية والعلمية والأخلاقية وباتت عبئاً وعثرة على دروب التحرر الفكري البشري، حين استحضارها راهناً وبكلّ شحناتها التاريخية الكلاسيكية وخاصة المفاهيم الدينية التي ترفض المساءلة والاستنطاق. لذا بات لزاماً علينا نقدها، إمّا باعطاءها مضامين جديدة في سياق صيرورة عملية التطور والتغيير الاجتماعية، أو حفظها في متحف الأفكار والمصطلحات المتهالكة.
إنّ المفاهيم في رحلتها الزمانية ونقلتها المكانية تفقد الكثير من سمات محتوياتها وخصوصية دلالاتها أو تكتسب صفات جديدة. ولنأخذ أمثلة من منظومة الفكر الديني الإسلامي وننظر فيها بعقلانية، ودون خشوع مسبق أمام سطوتها ورهبتها التاريخية خائرين ومستسلمين لحد القداسة وتقديم الطاعة العمياء لها بلا رويّة وبلا تفكير مع أنّ الإنسان هو المنتج والصانع لها وهو الكائن القدسيّ والأعظم، وإذا به يسقط عبداً في حضور كلمات تضخمت في مخيّلته حتى باتت تابوات محرّمة لا ينبغي المساس بها : كمفهوم الكافر والمشرك والتكفير، الالحاد والزندقة، البيعة والرعية، الجهاد، الفتوى…الخ
هذه المفاهيم هي من نتاج بيئة إجتماعية تاريخية وسياسية محدّدة وصلت إلينا، وشكّلت طبقات رسوبية في عقول أجيالنا وثقافتهم المتوارثة.
والمؤسف هو أن نتعاطى معها بمعانيها القديمة وبشكل آلي دون أي فحص ونقد، أو بحث في تاريخ ظهورها ومرجعيتها والهدف من استعمالها ومشروعية استعمالها وضرورة رميها ونبذها.
هل من المعقول ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نتداول هذه المفاهيم بكامل شحنتها العنفية والقاسية والتي ولّدتها بيئة اجتماعية صحراوية قروسطية، والتي ربّما يمكن أن تجد بذورها في أعماق كينونة النفس البشرية..! أيعقل أن نصنّف المواطنين في الدول المدنية المعاصرة إلى كفّار ومؤمنين ونفتي بقتل الكفار منهم…؟ أو نصنّف شخصاً ضمن خانة الزندقة وبالتالي نفتي بتصفيته صلباً وتقطيعاً استناداً إلى نصوص يُنظر إليها على أنّها قطعية ومطلقة وصالحة لكل الأزمنة والأمكنة. بحجة الإفتاء يفرّغ الكثير من البشر سموم غرائزهم العدوانية والتدميرية ويرتكبون كلّ جرائم العنف والإرهاب ويوقعون الأحكام نيابة عن الله بذريعة إنّهم وكلاؤه، وبإسم الله يحصّنون أفعالهم الشريرة، حتى لا يطعن أحد في صحتها أو يشك في مشروعيتها.
إنّ فتاوى الخميني ضد سلمان رشدي ليست إلا امتدادا لفتاوى صلب الحلّاج وقطع أوصال جسده، ومثله مقتل السّهروردي. وتكريس لعقلية القرون الوسطى التي لا زالت مستمرة
منذ فتاوى الغزالي وابن الصلاح في تحريم الاشتغال بالمنطق والفلسفة وتسفيه المتعاطين معها..؟ ما زال العصابيان ابن تيمية وابن قيّم الجوزية يعيشان معنا. أما كفى ديمومة استعمار العقل منذ المئات من القرون. أليس من حقّ العقل العيش بحرية بمنأى عن القيود والإملاءات.
من الجدير بالذكر والمقارنة، أنّ الدكتاتوريات المعاصرة، والحكومات الإستبدادية تسلك نفس الأسلوب في التعامل مع رعاياها (مواطنيها). حينما تصنفهم ضمن خانتين : المؤيدين والمعارضين كمصطلحين بديلين عن المؤمنين والكفّار..! وعليه يعيش المؤيدون في نعيم الدولة وجنتها، بينما يلاقي المعارضون أشدّ أنواع العذاب في سجون ومعتقلات السلطة وسعيرها. ما أشبه المعتقل بجهنم..!
ثالثاً – إسلاميات وخلاصات :
يقول الكاتب جمال حمي أنّ كل الانتفاضات الكوردية قادها رجال ذو خلفية دينية إسلامية. في إشارة منه إلى صلابتهم ونقاء فكرهم المستمدّ من خلفية إسلامية.
لا أنكر الخلفية الدينية لكثير من قادة الانتفاضات، ولم لا لأنها المرجعية الثقافية لأولئك الأشخاص باعتبارها الثقافة المهيمنة والسائدة. ومع ذلك فإنّ دعواتهم لم تكن دينية بل كانت تستهدف رفع الغبن عن الشعب الكوردي وإحقاق حقوقه الوطنية. فالشيخ عبيدالله النهري كانت له دعوة صريحة لاستقلال كوردستان وكذلك الشيخ سعيد بيران الذي قاوم غدر أتاتورك. فضلاً عن ذلك هل كانت ثورة إحسان نوري باشا وجمعية خويبون دعوة دينية ..؟ وهل كان عبدالرحمن قاسملو الماركسي رجل دين وبعده صادق شرفكندي وقبلهما قاضي محمد وسمكو آغا؟ وهل كان ملك كوردستان محمود الحفيد رجل دين..؟ وهل كانت حركة البارزاني الخالد حركة دينية أم قومية..؟ لا ينبغي تناول المواضيع بمنهجية انتقائية تجزيئية.
يشيد الكاتب بموقف الوفد الإسلامي الذي واجه كسرى ساسان بالرّوية والأخلاق الرفيعة حينما دعوه للإسلام، ويذم الساسانيين لأنهم قابلوا أولئك الأجلاف بفظاظة وسوء معاملة.
لقد عمل محمد وأتباعه لمدّة ثلاث عشرة سنة في مكة، على نشر دعوته ولم يستجب له ألا بضع عشرات من المستضعفين وبعضا من بني جلدته، في حين أنّ الأغلبية المطلقة من أعمامه وأبناء عمومته وعشيرته قابلوه بالعنف والأذى فكان يضطر للاختباء هنا وهناك، في غار حرّاء أو في دار ابن الأرقم..! إلى أن هاجر إلى المدينة. فإذا كان هذا هو حال محمد بين أهله وعشيرته. فهل كان مطلوباً من الساسانيين أن يفرشوا السجّاد الأحمر للوفد ويرشوا عليهم ماء الورد ويشهروا إسلامهم على الفور..!
لقد لاقى الكورد على أيدي المسلمين الغزاة الكثير الكثير من الويلات وجرائم القتل والسبي والنهب، تلك هي نتائج دعوة اتخذت القتال بحدّ السيف منهجاً ومذهباً في غزواتها المتعددة الأهداف ولا أعتقد أن الله يفتن عباده بعضهم ضد بعض، وأمثلة التاريخ لاتعدّ ولا تحصى منذ ما يسمى بالفتوحات الأولى وحتى الفتوحات الإسلامية المعاصرة.
إنّ جرائم الإبادة العرقية في زمن النظام العراقى البائد تحت راية الله أكبر هي أنجس خديعة للعقل البشري الجاهل وأرذل تلاعب بعواطف البسطاء. وما جرائم داعش الإرهابية بحق الكورد الأيزيديين، أو تلك الجرائم التي إرتكبتها وترتكبها تركيا في شمال كوردستان، وجرائم ميليشيات أردوغان المسلم من فصائل الجيش السوري الحر في عفرين ورأس العين، أو ما إرتكبته ميليشيات الثورة الإسلامية الإيرانية بزعامة الخميني الذي أفتى بالحرب المقدسة ضد الكورد في شرق كوردستان والإعدامات المستمرة بحق الكورد وإلى الآن أمثلة حية على استمرار حالة العنف الممنهجة والمذهبية من أخوّة الدين الإسلامي “الشعار الملغّم “. وهي ليست إلا امتداد لحروب الفتوحات الأولى واستمراراً لها.!. فما قول الأئمة والإسلاميين بشأن ذلك وما هي فتاويهم..؟ هل سيرفعون عنهم الهوية الإسلامية…؟ أم سيقولون أنّه حكم الله…! هل يتجرؤون على إشهار الحقيقة..؟ هل أدان شيخ الأزهر قصف حلبجة وحملات الأنفال..؟ ومثله إمام الحرمين، وكل أئمة الدين الإسلامي ما نلاحظه اليوم، أنّ هناك مئات الأديان الإسلامية نعم أقول أديان ففي كل دولة دين إسلامي وأئمة في خدمة الحاكم يشرعون له الفتاوى ويمجّدون سيرته.
فمن ألحق أكبر الضرر بالكورد : الإسلاميون أم جگرخوين.؟ أن الاحتماء بعلم كوردستان وصورة البارزاني ليست كافية لاكتساب الهوية الوطنية الكوردية والكوردستانية فالكوردي الحقّ هو كوردي قبل أيّ هويّة أخرى.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=43488