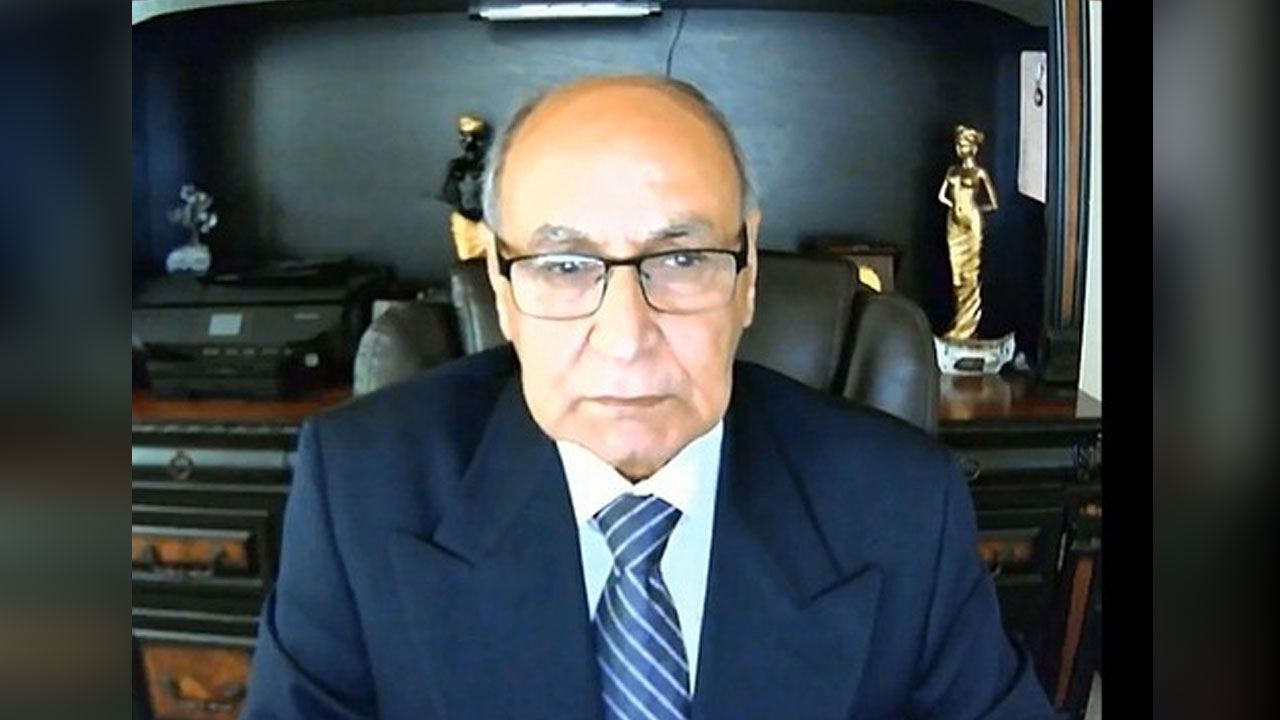د. محمود عباس
حين تُستدعى صورة صدام حسين لتبرير الحاضر، يصبح السُّنّة رهائن خطاب لا يمثّلهم، ودولة تُبنى على ذاكرة القمع لا على عقد وطني جامع.
أكثر من نصف المسلمين في العالم من السُّنّة، وهم مكوّن ديني واسع ومتنوّع، لا يمكن اختزاله في حكومة، ولا مصادرته باسم جماعة، ولا احتكاره عبر سلطة عابرة. ومع ذلك، جرى تسويق الحكومة السورية الانتقالية بوصفها ممثلًا “صاعدًا” لهذا المكوّن، مستندةً إلى دعمٍ إقليمي ودولي بُني على هذا الادّعاء تحديدًا. غير أنّ الوقائع على الأرض سرعان ما كشفت فجوةً خطيرة بين الخطاب والممارسة، حيث تُستَخدم الهوية السنية كغطاءٍ سياسي لتبرير العنف، وتبييض الإقصاء، وإعادة إنتاج الاستبداد، ولكن هذه المرّة بأدواتٍ جديدة وعناوين مختلفة.
هذا المقال لا يهاجم السُّنّة، بل يدافع عنهم، عبر تفكيك هذا الادّعاء، والتمييز الصارم بين السُّنّة كهوية دينية جامعة، وبين السُّنّية السياسية حين تتحوّل إلى أداة هيمنة وتطرّف.
غير أنّ ما جرى على الأرض السورية كشف، وبسرعة، التناقض البنيوي في هذا الادّعاء. فبدل أن تُعيد هذه الحكومة الاعتبار للمكوّن السني بوصفه مكوّنًا وطنيًا جامعًا، أقدمت، بأفعالها وخطابها، على تشويه سمعته داخليًا وخارجيًا. في الساحل السوري، جرى تبرير المجازر على أنها “ردّات فعل” لمجموعات منفلتة في مواجهة فلول نظام الأسد، وفي السويداء صُوّرت الانتهاكات بوصفها صراعات عشائرية سنية بحجج واهية، وفي دمشق جرى تدمير كنيسة مار إلياس مع تحميل المسؤولية لمنظمة “خارجة عن السيطرة”، وكأن الدولة بريئة من الفعل أو من العجز. أمّا في المناطق الكوردية، فقد أُعيد إنتاج خطاب الأنظمة البائدة ذاته، لكن بصورة أكثر فجاجة، وبوجوهٍ جديدة، وتحت ذرائع سياسية واهية، لا تخفي جوهر الإقصاء والعداء.
وربما كان يمكن لبعض الدول الداعمة أن تغضّ الطرف عن هذه الوقائع، أو أن تبرّرها مرحليًا تحت عناوين “الاستقرار” أو “الانتقال”، لكن ما لا يمكن تبريره أو التغطية عليه أخلاقيًا وسياسيًا هو تمجيد صدام حسين، الرمز الأشدّ قتامة في تاريخ الاستبداد الحديث. صدام الذي أذلّ الكويت، واستعمل السلاح الكيميائي ضد الكورد، وقتل من الشعب العراقي ما لا يقل عمّا قتله بشار الأسد ووالده من السوريين.
وهنا تُطرح الجدلية الأخلاقية الفاضحة بلا مواربة:
هل تُغفَر الجرائم في العراق والكويت وضد الشعب الكوردي لأن مرتكبها سنّي؟
وهل يُدان بشار الأسد لأنه علوي؟
أم أنّ كليهما، بلا استثناء، يندرجان في خانة قذارات البشرية التي لا مذهب لها ولا طائفة؟
وعلى هذا الأساس المنطقي، تبيّن أنّ الجولاني والبغدادي لم يقاتلا في العراق إلى جانب أبي مصعب الزرقاوي دفاعًا عن الشعب العراقي، ولا نصرةً لكرامته أو سيادته، بل في سياق ثأرٍ سياسي–مذهبي، دفاعًا عن البعث السني العروبي، واستعادةً لهيبة صدام حسين بوصفه رمزًا سنّيًا مخلوعًا. وبالمنطق ذاته، لم تكن “جبهة النصرة” ولا “هيئة تحرير الشام”، ولا سائر التنظيمات التكفيرية التي قادها الجولاني في سوريا، تقاتل دفاعًا عن الشعب السوري، ولا عن سوريا كوطن جامع، بل كانت تخوض حربًا ضد النظام العلوي وأدوات النفوذ الشيعي حصراً.
ولو كان صدام حسين في موقع بشار الأسد، يمارس القتل ذاته بحق السوريين، لما حمل الجولاني ولا النصرة ولا أيّ من التنظيمات السنية المتطرفة السلاح ضده، بل ولربما قاتلوا إلى جانبه ضد الثورة السورية نفسها، التي جرى تحريفها عن مسارها الوطني. فالصراع، في جوهره، لم يكن يومًا صراعًا ضد الاستبداد، بل صراع هوية ومذهب وسلطة. ومن هنا، لم تكن سوريا في مواجهة مشروع وطني بديل، بل في مواجهة نظامٍ يتخفّى خلف لافتة السُّنّة، بينما يعكس في بنيته وسلوكه التطرف والإرهاب داخل المكوّن السني نفسه.
وبذلك، لم يُظهر هذا التيار أيّ طموح حقيقي لبناء وطن يتّسع لكل مكوّنات سوريا، بل سعى إلى إعادة إنتاج نظام سنّي استبدادي، لا يختلف في جوهره عن الأنظمة التي ثار عليها. وهذا ما يفسّر إصراره على النموذج المركزي الصلب، أي منطق “الإمارة” لا الدولة، ومنهج الإقصاء لا الشراكة، وهو ما يفضح الخلفيات الفكرية والسياسية الكامنة خلف الشعارات التي رُفعت، والتي استُدعِي فيها التاريخ لا لبناء الحاضر، بل لتبرير الهيمنة فيه.
بهذه الانزلاقة السياسية–المذهبية، أثبتت الحكومة السورية الانتقالية أنّها لا تمثّل المكوّن السني، بل تمثّل مجموعات تكفيرية متطرفة، تحمل إرهابًا فكريًا ووباءً ثقافيًا، مهما حاولت الاختباء خلف الوهابية أو استدعاء تراث ابن تيمية. وهذه المنهجية، عاجلًا أم آجلًا، ستفتح شرخًا عميقًا بينها وبين أنظمة الخليج العربي نفسها، لأن التاريخ لا يُمحى بالتقادم، ولأن دولًا كالكويت لا يمكنها أن تنسى ما فعله بها صدام حسين والبعث، مهما تغيّرت الرايات وتبدّلت الواجهات.
ولعلّ هذا ما يفسّر التحوّل الملحوظ في خطاب بعض وسائل الإعلام الخليجية، كـ العربية والحدث، حيث بدأت تتسرّب نبرة الشكّ والتحفّظ تجاه موجات التطرف والكراهية التي تنتشر، كوباء، بين مؤيدي هيئة تحرير الشام والحكومة الانتقالية، حتى مع محاولات تلميع أحمد الشرع وإخفاء الجولاني عن الواجهة. وهو ما دفع بعض المسؤولين إلى إطلاق تبريرات متأخرة، تزعم أن الدولة “تحاول ضبط الخطاب”، وأنها “تسعى لحماية المكوّنات السورية”، بما فيها السنّة الذين يختلفون مع سياساتها. غير أنّ هذه التبريرات، حتى اللحظة، لا تتجاوز كونها مناورة إعلامية، لا ترقى إلى مستوى مراجعة حقيقية.
ليس مستبعدًا، في هذا السياق، أن تعيد بعض الدول حساباتها، وأن تندم على الأموال الطائلة التي أُنفقت دعمًا لهذه السلطة، وأن تحجم عن الاستثمار في سوريا وهي ترى شعارات تمجيد صدام حسين تُرفع علنًا، مع ما يرافقها من استدعاءات تاريخية كـ“خيبر”، التي حرّكت بالفعل قوى مؤثرة في الغرب، وستترك أثرها عاجلًا أم آجلًا على مواقف الدول الكبرى، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة. فرفع بعض القيود وإلغاء قانون قيصر لم يكن شيكًا على بياض، بل جرى بشروط تكاد تكون أعمق من قدرة هذه الحكومة على الوفاء بها. فالمطلوب عمليًا ليس تغيير خطاب، بل تفكيك بنية فكرية جهادية، أي مطالبة مقاتلين خاضوا سنوات تحت شعار “الجهاد” بالتخلي عن المفهوم الذي حاربوا من أجله، وهو أمر بالغ التعقيد.
إذا لم تُجرِ الحكومة السورية الانتقالية مراجعةً جذرية لسياساتها، ولعلاقتها مع المكوّنات السورية، وفي مقدّمتها الشعب الكوردي، فإنها ستنحدر سريعًا إلى مستنقع التطرف والكراهية، ولن تُجدي معها محاولات التجميل السياسي، داخليًا أو دوليًا. بل ستغدو هذه المنهجية نفسها بذرة سقوطها وزوالها، كما تُثبت سنن التاريخ في مصائر الأنظمة التي عجزت عن مراجعة ذاتها.
فكما تقول سنن التاريخ:
كل نظامٍ استبدادي يحمل في داخله أسباب فنائه، مهما طال أمده وتغيّرت شعاراته.
الولايات المتحدة الأمريكية
13812/2025م
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=81347