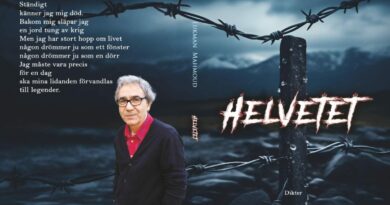جدارية محمود درويش بين قراءتين
فراس حج محمد| فلسطين
“انتهت القراءة الأولى الساعة 7:45 مساء يوم الاثنين 19/6/2000” هذا ما كنت كتبته في الصفحة الفارغة مع توقيع اسمي الثنائي (فراس عمر) نهاية ديوان محمود درويش الجدارية. كان من عادتي أن أكتب في ذيل الكتب المقروءة متى أنهيت قراءتها، إلا أن ما لفتني إلى ملاحظتي هو أنني وصفتها بالأولى. هل كنت أفكر في ذلك الوقت أنني سأعود إلى الديوان ثانية؟ لم أعد إليه إلا بعد أكثر من ثلاث وعشرين سنة!
بقي الكتاب على رف المكتبة بين كتب درويش الأخرى، إذ لم يحدث لي أن أعدت قراءة كتاب قراءته، إلا المصحف الشريف، أما ما عدا ذلك فقراءة أي كتاب تغني عن قراءته مرة أخرى، نظرا إلى أنني لا أتعلق بكتاب ما تعلقا مرَضيا مهما كان الكتاب، ولم يحدث أنْ قلت إن هذا أفضل كتاب قرأته، ويا ليته لم ينته! ولا أنصح الآخرين بقراءة أي كتاب قرأته، فالكتاب قرئ وانتهى، وتبقى الملاحظة التي أكتبها وما علق في ذهني من الأفكار كل ما يتصل بهذه القراءة من أدلة. أظن كذلك، وهذا لي وحدي، أنه لا كتاب يستحق أن تقرأه مرتين، فما الجديد الذي ستلقاه؟
بعيدا عن نظريات القراءة والتلقي، فإن هذه مسألة أخرى، إذ قد تعيد قراءة جملة، فيتكون عندك فهم لها في مرحلة ما، ثم يتبادر إلى ذهنك معنى محتمل آخر بفعل ظروف معينة، كما حدث مع جملة غسان كنفاني وسؤاله العابر للأفهام “لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟” وأمثلة كثيرة من آيات القرآن الكريم التي فهمت على وجه ما في زمن ما ثم تغير المعنى المدرك. لم أفكر بالكتب التي قرأتها على هذا النحو. كنت أقرأ دون أن أكتب، ثم أخذت أكتب حول ما أقرأ، ثم أكتب دون أن أقرأ.
دفعتني هذه الملحوظة أن أكتب مرة أخرى أسفل الملحوظة السابقة “القراءة الثانية الساعة 11:49 مساء يوم الأربعاء 23/3/2024، ولم أوقع اسمي كما وقعت المرة السابقة. لقد اختفى اسمي الثنائي الآن ليحل محله اسم آخر ثلاثيّ التركيب بفعل غواية التأليف والنشر.
ولكن، هل سأعود إلى قراءة ثالثة للديوان؟ لست أدري. إحساس يقول لي ربما لأنني أيضا وقعت تحت تأثير الحدس المستقبلي الغامض عندما وصفت القراءة بأنها “ثانية”، ويستدعي هذا العدد الترتيبي أن تكون هناك ثالثة ورابعة وخامس، أو على الأقل ثالثة، وإلا كما علمتنا اللغة العربية علينا أن نقول القراءة الأخرى، قراءتان اثنتان لا ثالث لهما، كما هو ربيع الأول والآخر وجمادى الأولى والآخرة، وكما هي الحياة الدنيا (الأولى) والحياة الآخرة، لا اعتبار لحياة أخرى مزعومة تسمى “حياة البرزخ”، فهي محسوبة على الآخرى وليس على الدنيا، أو أنها غير موجودة أصلاً، وهذا ما أرجحه كما جاء في أدلته التفصيلية في موقعه، وبالتأكيد فإن هذا ليس هو موقعه لأشرحه.
لا أستطيع أن أطبق على نفسي مقولات نظريات التلقي والقراءة المتعددة لهذا النص، لأنني لا أدري ما الذي اختلف عليّ وفيّ بسبب قراءة الديوان مرتين في زمنين مختلفين، ولا أدري ماذا كان يمثل لي الديوان أول أن قرأته والآن اختلف. المسألة تدور في فلك العبث، إنما هو كتاب قرأته حينها لأنه كتاب جديد للشاعر محمود درويش الذي قرأت كل شعره ونثره وكثيرا مما كُتب حول أدبه، ودرسته قبلها في رسالة الماجستير، ولم يكن حينها عندي أي كتاب سوى بحث الرسالة المخطوط، وما زال مخطوطاً، ولعله سيظل مخطوطاً.
ما أستطيع طرحه هنا وأستطيع الإجابة عنه؛ سؤال: لماذا قرأت الديوان من جديد؟ قرأت الديوان في غمرة الإعداد لكتاب جديد أدرس فيه نماذج متعددة من النصوص الشعرية والسردية والأعمال الدرامية، بلغت عشرة أعمال، أخضعها كلها للبحث البنيوي لمعرفة ما فيها من عناصر ثقافية متأثرة بها، مما يقع عند الكتاب في العادة، وأصبح ظاهرة في الدراسة، بل موضة لم يسلم منها ناقد أو دارس أو كاتب، وخاصة في النقد البنيوي، والنقد الثقافي، لذلك عدت إلى الكتاب لأقرأه قراءة لا تقع ضمن شروط قراءة “المستمتع” بل تحت التفتيش عن “الصناعة” التي شكلته، ليظهر بهذه الصورة. قراءة أفقدتني الإحساس بلذة الشعر واللغة. ربما هنا تتدخل نظريات التلقي التي تتفهم الغرض من القراءة وأهدافها. القراءة تفصح عن نفسها أنها ليست بريئة إطلاقا من سوء النية والانتهاك للنص وما بعد النص وما قبله.
كانت نتائج هذه القراءة مذهلة؛ القراءة الأولى كانت صامتة، لم أمرر قلما أو أخطّ سطرا أو أكتب ملحوظة على هوامش الصفحات، وبقي الديوان أنيقا ونظيفاً والنص مشعّاً برّاقاً، حتى الملحوظة الخاصة بتاريخ القراءة الأولى استخدمت لكتابتها قلم الرصاص. هل كنت أحترم الكتب أكثر في تلك المرحلة؟ ربما، هو شيء أكبر من الاحترام؛ فليس من حقك أن تعبث بأي كتاب بمثل هذه الخربشات العابرة.
في القراءة الثانية الفاقدة للذة الاستماع بالشعر وباللغة، كانت لأغراض البحث، صحيح أن ما هو مشترك بين القراءتين هو أن الديوان قرأته في كل مرة في جلسة واحدة، في الأولى لم أخرج خارج الديوان، وفي الثانية ظللت أخرج والديوانَ إلى الآخرين السابقين له وأعرض عليهم درويش ومقولاته، وأقول: هنا مر آخر من قبل درويش، فأعاد النص كلامهم واستعاره، وأحيانا حطّمه وأحيانا بدله، وأحيانا قلّده، وأحيانا تمرد عليه.
في هذه القراءة امتلأت الصفحات بالخطوط والخربشات المكتوبة بقلم الحبر، وغصّت بالاستحضارات لكتب الآخرين ومقولاتهم، الوجوديين، والصوفيين والشعراء والمفكرين والفلاسفة، واستحضرت المقولات الشعبية، والنصوص الدينية القرآنية والتوراتية والنبوية. كنت أسعى إلى تعرية النص والكشف عما وراءه من نصوص، ليصبح الكتاب كارثيا، ويصدق فيه ما كنت سجلته عن نفسي “أن أي كتاب أقرأه لا يصلح لذي قارئ بعدي” من كثرة هذه “الخربشات”. وهي عادة اعتدت عليها بعدما أصبحت مؤلفاً. فنادرا ما يظل الكتاب سليما معافى وهو بين يديّ. لذلك ربما من أجل هذا لا أستطيع قراءة الكتب الإلكترونية إلا في الضرورة القصوى، لأنها تحرمني متعة الخربشة على جسد النص، فيظل أعلى مني، ولا أتمكن من ركوبه والسيطرة عليه تماماً، فتزوغ مني أفكاره وأتوه، فلا أدري أين ذهبت بوصلتي الهادية.
بدا لي أن درويش بعد هذه “المكنكة” النقدية “حطّاب” لغة وثقافة أكثر منه شاعراً؛ جديده قليل ونادر، لكنه ذو اطلاع ومعرفة، ويصحّ فيه ما كنت قلته عن أدبائنا أنهم في الغالب “نصوصيون”، على الرغم من أن هذه الصفة قد تقرّبهم إلى أنهم “لصوصيون” أو “متلصصون”- في أحسن الأحوال- على الآخرين، يطلون عليهم من شرفات الكتب، فيسرقونهم دون إذن!
أهم ما قالته لي القراءة الثانية أن البراءة من دم النصوص السابقة شيء نادر الحدوث، بل ربما عدّ النقاد أنه أمر لازم، فليس سهلا أن تكتب من فراغ الفكرة أولا، ناهيك عن فراغك من أساليب الآخرين وتعبيراتهم وأطرهم العامة التي قرروها، وعرفت في عناصر الشكل الفني المكونة للجنس الأدبي.
أظن أن من واجب الكتابة اللاحقة تحطيم كل كتابة سابقة ذات صلة، وجعلها ركاماً، لا ملامح لها، لإعادة استخدام هذا الركام مرة أخرى، وإلا فإن النتيجة نص فيه من لحم النصوص الحية وروحها الشيء الكثير ما يفقد النص الجديد شخصيته الإبداعية، ويجعله معلّقا بالآخرين تعلّق ضرورة ووجود، وهذا ما لا تقوله أصول صنعة الكتابة، بل إن التحرر من الآخرين شرط أي إبداع حقيقي، وليس الإقامة في النصوص على نحو يجعل الكاتب أسير مقولاتها وأهدافها وشروط كتابتها الأولى.
طرحت ذات مرّة سؤالاً؛ “هل قتلتَ يوماً شاعراً كبيراً؟”، وقررت فيه أنه إذا أردت أن تكون شاعرا، عليك أن تفعلها، وتقتل شاعرا كبيرا، وحددت لذلك ثلاثة شعراء: أدونيس، ونزار قباني، ومحمود درويش، إنما ما قالته لي القراءة الثانية للجدارية أن درويشاً أتى بكثير من الشعراء وغير الشعراء وأحياهم في قصيدته، وأجلسهم على مقاعد حجبت صورته، أو كادت، فهل كنت مخطئاً في ما توصلت إليه من نتائج لهذه القراءة؟ وهل أفلحت القراءة الثانية للجدارية أن تقضي على القداسة أيضاً وليس على المتعة فقط؟
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=39918